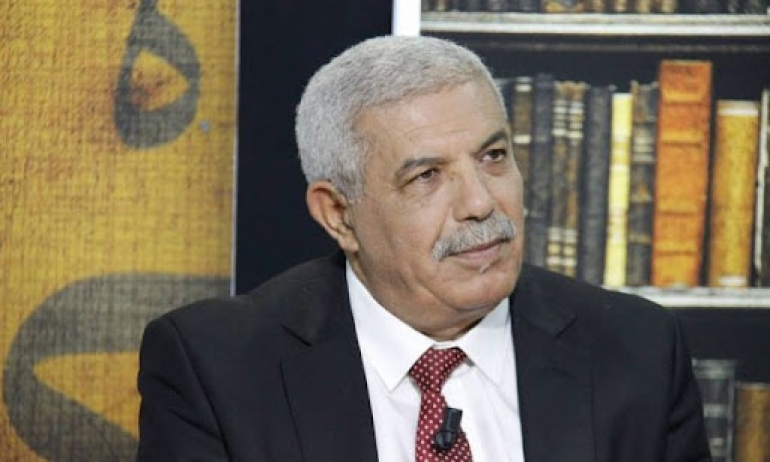في ظل التحولات الكبرى في المنطقة . كما تطرق الى موقف تونس من هذه القضية منذ زمن بورقيبة. وأكد بأن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة كان من أوائل الذين لفتوا وحذروا من خطورة الصهيونية كنظام احلالي وليس فقط استعماري . واكد أن خطة ترامب لترحيل الغزاويين هي امتداد لنظرية الصهيونية الاحلالية . فيما يلي نص الحديث .
انطلاقا من كتابكم بورقيبة والقضية الفلسطينية الى أي مدى يمكن اعتبار وعد ترامب امتدادا لوعد بلفور؟
هذا الكتاب هو امتداد لكتاب آخر كنتُ أصدرته بعنوان تطور الخطاب السياسي في تونس تجاه القضية الفلسطينية من عام1920 الى عام 1955. وجاءت الفكرة من هذا الكتاب باعتبار أن بورقيبة كان من أوائل السياسيين الذين اهتموا بهذه القضية 1938 خاصة في الاربعينات، وذلك عند اقامته في القاهرة سنة 1945 ثم فترة الاستقلال الى ذلك . بالتالي ما أثرناه في هذا الكتاب هو موقف بورقيبة ، البعض يتحدث فقط عن دعوته للاعتراف بالكيان الصهيوني في حين ان بورقيبة قدّم رؤية متكاملة لهذا الموضوع. اولا بورقيبة كانت له نظرة متميزة بالنسبة للصهيونية وهو من الأوائل الذين حذروا منها . وحتى الفلسطينيين لم يتحدثوا عن الصهيونية كنظام احلالي ، تحدثوا عنه تقريبا في السبعينات ، في حين ان بورقيبة تحدث عنه في الوثيقة الذي صاغها باسم زعماء المغاربة في القاهرة وقدمها الى اللجنة الانغلوسكسونية وتحدث فيها عن نقاط أساسية منها ان الصهيونية هي نظام احلالي وليس فقط نظام استيطاني . فما حدث في الجزائر ليس نظام فصل عنصري مثلما حدث في جنوب فريقيا انما هو نظام احلالي اي يحل شعب محل شعب آخر وهذه هي صلب النظرية الصهيونية التي تعتمد على مبدأ هجرة او تهجير اليهود من أصقاع العالم الى فلسطين.
النقطة الثانية هي محاولة منع اليهود للاندماج في بيائهم الطبيعية حتى يقوموا بالهجرة الى فلسطين . والنقطة الثالثة هي ترحيل الفلسطينيين من أرضهم الاصلية الى خارج فلسطين. وهذه العناصر الثلاثة هي أساس النظرية الصهيونية. وبورقيبة كان على وعي وادراك بهذه المسألة . ولكن عندما طرح في سنة 1965 قضية الاعتراف بالقرار 181 كان في الواقع يدعوا الى ان تكون للفلسطينيين أرضا ودولة يمكن ان يقاوموا من خلالها الاحتلال. لأنه سنة 1965 كانت غزة تابعة للنظام المصري والضفة الغربية كانت تابعة للملكة الهاشمية . فهو دعا الى ان يستقل الفلسطينيون بدولة خاصة ،ويقوموا بالنضال المسلح ضد الكيان الصهيوني كما حصل في الجزائر ضد فرنسا. كما دعا لأن تكون للمقاومة الفلسطينية حاضنة لها بمعنى خلفية لها كما كان الحال بالنسبة للجزائريين الذين وجدوا في تونس بعد استقلالها الخلفية التي يلتجئون اليها والتي يناضلون من خلالها .
هل تعتبر اذا ان وعد ترامب هو امتداد لهذه النظرية الصهيونية الاحلالية؟
النظرية التي تحدثنا عنها أي الصهيونية الاحلالية نجد انها تطبق منذ سنة 1948 ولذلك وُجد اللاجئون الفلسطينيون بدول الطرق وهُجّروا اليها . وهذا المبدأ هو مبدأ أساسي تحاول الصهيونية ككيان القيام بكل ما تستطيع لتنفيذه. من ذلك ما نشهده الآن من محاولت لترحيل الفلسطينيين من غزة وحتى الضفة الغربية وما يقع في جنين وغيره . وكلها تنصب في سياق تنفيذ المبدأ الأساسي في النظرية الصهيونية التي بنى عليها بشكل واضح وفج الرئيس الأمريكي ترامب خطته لغزة. ودعا من خلالها كلا من مصر والاردن لاستقبال هؤلاء المرحّلين من أراضيهم الطبيعية . وهذا ما يمثل نكبة ثانية حقيقية للفلسطينيين ان تمكنت الولايات المتحدة بتحالفها العضوي والاستراتيجي مع الكيان الصهيوني من تحقيقه وهو أهم الأهداف المركزية والاستراتيجية للكيان الصهيوني .
لو نعد قليلا أيضا الى كتابيكم "تطور الخطاب السياسي في تونس تجاه القضية الفلسطينية (1955-1920)"، على ماذا ركزتم في هذا الكتاب ؟
في الحقيقة تطرقنا فيه الى جوانب من التفكير السياسي التونسي في الشأن الفلسطيني. ففي الفصل الأول، ركزنا على الخطاب السياسي في تونس من الوعي بأهمية القضية الفلسطينية إلى إدراك مخاطر الصهيونية، ورصدنا العوامل التي ساهمت في تأخر إدراك الخطاب السياسي في تونس القضية الفلسطينية والأيديولوجيا الصهيونية وتفكيكها. ثم حاولنا إبراز العوامل التي ساهمت في إدراك الخطاب لتلك القضايا وحدود فهمه لها.
وفي الفصل الثاني، ترقنا الى تطور موقف الخطاب من السياسة البريطانية والنشاط الصهيوني في فلسطين (1920-1939)، وركزنا على تطور السياسة البريطانية في فلسطين والنشاط الصهيوني فيها وموقف الخطاب السياسي من تلك السياسة وإدراكه مدى خطورة النشاط الصهيوني على مستقبل فلسطين. وجدنا أن الخطاب السياسي في تونس تنبه سريعًا إلى خطورة هجرة اليهود إلى فلسطين وانعكاساتها على الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية للسكان الأصليين، "كما أدرك خطورة انتقال الأراضي من الفلسطينيين إلى الصهيونيين بوسائل شرعية وغير شرعية. وكانت المواقف حازمة لا تقلّ صرامة عن الموقف الفلسطيني العام ذاته الذي أكد إصراره على منع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود منعًا باتًّا ونهائيًا". وكان تعرّض تونس نفسها للهجرة المكثفة من الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين وغيرهم من الذين استوطنوا البلاد واغتصبوا الأراضي الفلاحية ونهبوا الخيرات واستغلوا اليد العاملة التونسية أبشع استغلال من أبرز العوامل التي ساعدت في اتضاح الرؤية.
وفي الفصل الثالث، اهتممنا بتطور رؤية الخطاب للمقاومة الفلسطينية (1920-1939)، وتناولنا تفكيك رؤية الخطاب لمظاهر مقاومة الفلسطينيين للاحتلال البريطاني والمشروعات الصهيونية في فلسطين. اذ تميّز محتوى الخطاب التضامني في تونس تجاه القضية الفلسطينية بالتجانس النسبي تجاه القضايا المحورية بالتحديد، وارتقى فهم الخطاب لأبعاد القضية وخصوصياتها تدريجًا إلى درجة الإحاطة بالمسائل كلها. وكان للمخاض الذي عاشه الخطاب السياسي في تونس بخصوص القضية الفلسطينية أثر فاعل في بلورة الرأي العام المحلي وتطوره وتعميقه في شأن قضاياه الداخلية.
وفي الفصل الرابع، أبرزنا موقف الخطاب من مشروعات التسوية السياسية التي طرحتها الإدارة البريطانية والبدائل التي طرحها الخطاب بصفتها حلولًا عملية لتلك القضية. رأينا أن هذه البدائل تميزت برؤية استشرافية جريئة عبّرت عن فهم عميق لجذور المشكلة التي ما كان بالإمكان معالجتها إلا من خلال حل جذري يتمثل في استقلال فلسطين، وفي بناء الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية العلمانية.
وكيف تقرأ اليوم التحولات في المنطقة وتأثير ما يحصل في سوريا على الاقليم؟
لا شك أننا نشهد العديد من التحولات الدراماتيكية ولعل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو كان قد لوح بحدوثها عندما قال قبل سقوط بشار الاسد والنظام السوري بأنه سيغير خارطة المنطقة . وفي الواقع هو تمكن جزئيا على الأقل من هذا الهدف وهو أمر كان مخططا له منذ فترة ليست بالقصيرة.
وبغض النظر عن طبيعة النظام السوري السابق لكنه كان يمثل بيئة مفتوحة للمقاومة سواء الفلسطينية او اللبنانية .
فالحدود السورية البرية كانت الوحيدة التي يأتي منها السلاح للمقاومة . فكانت استراتيجية الكيان الصهيوني خاصة بعد عام 2006 تتركز على ضرب هذا الحلف . وأعتقد ان ما كان يزعج العرب وحتى كل من يلتقي مع الكيان الصهيوني ليست قضية الديمقراطية في سوريا لان طريقة رئاسة بشار الاسد كانت معروفة ومقبولة من الجميع وهي طريقة سائدة في عديد الأنظمة العربية . كذلك حتى قبيل زحف الجولاني وجماعته كان بالإمكان لبشار ان يعقد الاتفاقية التي عرضت عليه لاستقبال اردوغان والاتفاق حول برنامج سياسي معين لإدخال المعارضة كجزء من النظام. وهنا أكرر انه منذ 2006 كانت هناك استراتيجية كاملة لإسقاط النظام السوري . وبعد ما حدث في طوفان الأقصى وبعد الضربة الموجعة والعميقة للمقاومة في لبنان وهي الرديف المناصر لدمشق التي حاربت ضد المجموعات السلفية التكفيرية . بعد هذه الضربة تسنى لهذا الحلف التركي الامريكي الصهيوني من اسقاط النظام. لذلك كما لاحظنا منذ لحظة السقوط اسرع الكيان الصهيوني بضرب كل ما تملك سوريا من أسلحة وطائرات وثكنات وغير ذلك .
ونتيجة لسقوط النظام تغيرت كل المعطيات في المنطقة لأن ايران ضُربت بعمق نتيجة لهذا التحالف وحزب الله الآن يعيش تحديات صعبة . واعتقد أن ما حصل في سوريا وتحويلها الى دولة منزوع السلاح وقابلة للتطبيع مع الكيان الصهيوني هو أقصى ما كان يتمناه الصهاينة .
فيما يتعلق بإصداركم الأخير حول « عقوبات النفي والإبعاد المسلطة على الوطنيين زمن الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية (1881-1955) لو توضح لنا أبرز ما تضمنه الكتاب ؟
في الحقيقة هو اول موضوع يتم التطرق اليه حول السياسة العقابية في تاريخ تونس المعاصر في الفترة الاستعمارية . وحتى الكتابات التي تناولت مسألة النفي والإبعاد حتى في فرنسا لم تهتم بهذا الموضوع الا في بداية التسعينات . واهتمت بالعقاب خاصة البدني والسجون وليس بالنفي .
حاولت في هذا الكتاب إلى إبراز بعض أشكال العنف والإيذاء النفسي والبدني الذي مارسته الجمهورية الفرنسية – الثالثة والرابعة بالبلاد التونسية – ضد السكان التونسيين وخاصة أولئك الذين عارضوا أو تصدوا لسياستها وعنفها .
كما حاولت في هذا العمل ان ننقل بقدر كبير من الموضوعية العلمية، صمود هؤلاء الوطنيين والسكان العاديين، المبعدين والمسجونين والمنفيين، في مواجهة هذا العنف الصاخب أحيانا والصامت في اغلب الأحيان .
ولئن تعددت أنواع العقوبات التي سلطها المستعمر وتراوحت بين السجن والفصل من الوظيفة والنقل التعسفية والإبعاد والنفي، فإننا اختارنا هذه العقوبة الأخيرة بالذات لنخصها ببحث شامل.
فالمستعمر الفرنسي سعى إلى « طمس التاريخ » ، أي طمس نشاط الحركة الوطنية في تونس، إلا أن هذه السياسة أفرزت نتائج عكسية، حيث تمددت الحركة الوطنية جغرافيا واجتماعيا في الداخل والخارج.