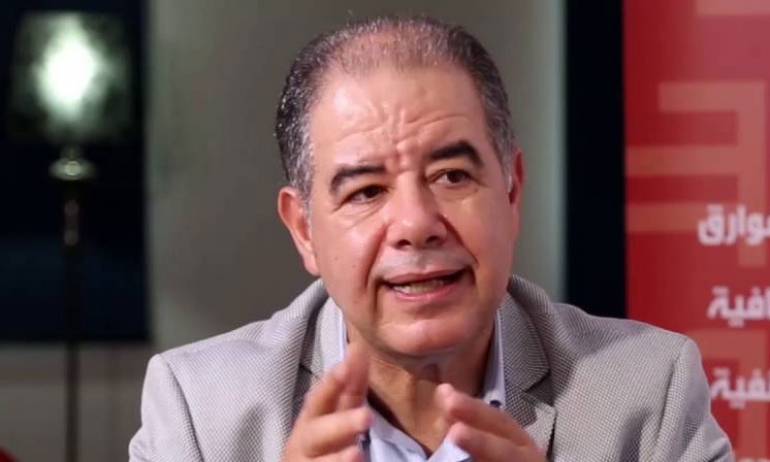التي أصابته مع بداية عشرينات القرن الحالي، أن يخرج صانع حكايات ماهر للناس ليذكّرهم، بالمعنى الحقيقي للاشتراك في الحياة، ويدُلّهم على ما تأتيه الحواس بعفو خاطر ومن دون مكذوب ادعاء، من ترفّق وحُسن تدبير؟
تلك كانت الطريق التي اختار كمال الهلالي ضمن روايته البكر، أن يَسْتَكْنِهَ عبر تجاويف مظانها الوعرة، مدلول ما هزّ روْعه من تصاريف عبثيّة ترصّدت طمأنينة معاش أرياف وديعة، أصرّ رهط من شياطين الإنس على تكدير معاشها، دافعين بساكنتها إلى مغادرتها والهروب دون رجعة مما استبدّ بها من أهوال.
فقد بدا لمؤلف رواية "الأوج الفسيح" الصادرة حديثا عن دار الجنوب ضمن السلسلة الأدبية الأثيلة "عيون المعاصرة"، أن ما استجلب في رهافة حسّ وتقصّد بديع من روايات رتّبها بشكل ضارع تقطيع المشاهد السينمائية المصوّرة ونشأت وتيرة عرضها عن نَفَسٍ مَتَحَ من موسيقى معافاة من كل نشاز، بوسعه أن يصيب مقصدا رفيعا في الدعوة إلى استفاقة من الغفوة وإقبال على جادة التراحم والتعافي وإدانة كل من ولغ في دماء طاهرة بريئة من الشُبهة. وهو لو ندري أجلُّ ما تأتيه معظم الكائنات توافقا مع فطرتها المجبولة على الحفاظ على تواصل الحياة، معوِّلة في جميع ذلك على أشكال معقّدة من التَحَوُّطِ الذكيّ على ما تُتيحه مراكمة الخبرات والـمَلَكات فوق أديم هذا الكوكب.
فما مقصد المؤلِّف من تضمين مدلول "الأوج الفسيح" بالتعويل على قصيدة ابن سينا (ت 1037م) "العينية في النفس والروح"؟ وما الذي دفعه إلى مقاسمتنا هذا النشيج الداخلي الحزين، عارضا علينا تصاريف الدمار بعد العَمَارِ، ومأساة خلاء بيوت العبادة ومزارات الصالحين وخواء العقول وفراغ الافئدة؟
"أوج" تفيأ فسيح جباله ثول من النحل راعيا في أفانين نباتاته البرية، مستطيبا شذي أزهاره، متنقلا بين بيوت معسَّلَة مسدسة الأضلع، عاجله كدر الزمان وأهله، فانفرط عقده، وانقلبت بساطة عيشه المحبّبة إلى كوابيس مفزعة، أقضّت مضاجع الاحياء، وأخرجت الأموات من رموسهم.
تلك "قيامة" ركّبها كمال الهلالي بسبق إصرار وترصد لحد لهما، حتى يتبين لقرّائه بعد انغماسهم في ايقاع إنشائه - وبمقدار ما تسمح به الرؤية من صفاءِ- الخط الأبيض من الخط الأسود. فيتدبُّروا عميق الدلالة فيما أورده الذِكر من: "أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" (الأنبياء، 105).
"العَالَمُ إِمَّا عَيْنٌ أو عَرَضٌ"
اختار المؤلِّف قبل الدخول في قصّ حكايته تصديرها ببعض من أبيات قصيدة ابن سينا "العينية" جاء فيها:
....
تَبْكِي إِذَا ذَكَرَتْ عُهُودًا بِالْحِمَى
بِمَدَامِعٍ تَهْمِي وَلَمَّا تُقْلِــعِ
وَتَظَلُّ سَاجِعَةً عَلَى الدِّمْنِ الَّتِي
دَرَسَتْ بِتِكْرَارِ الرِّيَاحِ الأَرْبَعِ
إِذْ عَاقَهَا الشِّرْكُ الكَثِيفُ وَصَدَّهَا
قَفَصٌ عَنِ الأَوْجِ الفَسِيحِ المُرْبِعِ
فقد جاءت تسمية "العينية" وفق ما أورده "كشاف اصطلاحات الفنون" من "العين فيما قام بنفسه جوهرا كان أو جسما، ويقابله ما قام بالغير كالأعراض"، وعلى هذا قيل "العَالَمُ إما عَيْن أو عَرَض." على أن دين المسلمين يفرّق من منظور خاص بين الروح التي تفارق الجسد بعد الموت، وبين النفس بوصفها مادة خالدة تحيل على الجزء اللطيف للذات البشرية، وهو الجانب المعني بالحساب بعد البعث.
وهكذا فإن صِلة الروح بالنفس، هي ما يشكل الذات على الحقيقة. وذاك مرد تشبيه النوم بالموت في القرآن، بوصفه قدرة الخالق على الفصل بين من حضر أجله فقضى نحبه، ومن لم يحن في حقه ذلك بَعْدُ. وهو أيضا عين ما أشارت إليه الآية 23 من سورة الأحزاب: "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا". كما تضمنت سورة الاسراء (وضمن الآية 17) تحذيرا صريحا يَنْهَى عن اللُجاجة في السؤال بخصوص معنى الروح: "يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أتيتم من العِلْمِ إلا قليلا". على أن يذهب أئمة الشيعة في تفسير الآية الثامنة من سورة الشمس: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها" مذهبا طريفا، معتبرين أن النفس هي العنصر الحي الذي يسكن الجسم على مدى ما قُدر لمادته أن تعيش، وذلك قبل أن تُقْبَضَ وتُعرض بعد نزعها من غلافها الجسدي للحساب في الآخرة، لذلك تُشحن كل نفس وفق طبيعة مؤهلات كل كائن حي، حتى وإن كانت أزلية، ونقية، وطاهرة. فلئن اتسم حضور الروح بالتقلّب والتقطع في الحياة الدنيا، فإن أمرها مختلف في مشيئة باريها. لذلك يغلب أن يحمل كل موجود روحا خاصة به تتوافق مع طبيعة المادة التي تركّب منها، في حين أن انعدم تلك القوة المحرّكة يعني بكل بساطة التلف والجمود.
والظن أن وقوع اختيار كاتب الرواية على عينة مختارة من أبيات "عينيّة" ابن سينا، هو ما شكّل فيما نعتقد محاولة لاستعارة نشيج النفس بعد مفارقة "أوجها الفسيح"، لتستملح العيش داخل قفص طيني ضيّقٍ. وهو على جميع ذلك ضرب من الإعلان عن توجّه تأملي صوفي، سابق لسرد الوقائع. ففي تلك القصيدة كَشْفٌ عن رأي ابن سينا في مسألة النفس وربط لها بـ "محل أرفع". فهي قد نزلت على كُره منها لتتصل بالبدن، لكنها ولئن ألفت وجودها هناك ونسيت عهودها السابقة، فإنها ستعود حتما أدراجها من حيث أتت، بعد استيفاء رحلة حياتها الاستكشافية.
فما الشيء الذي أرغمها على فعل ذلك يا تُرى؟
هناك في منطق ابن سينا حكمة إلهية في حصول هذا الهبوط القسري، فالنفس نزلت وهي لا تعلم شيء، لذلك أَنِسَتْ لقفصها ردحا من الزمن، قبل أن تعود بعد ذلك إلى "أوجها" عارفة بحقيقة ما يدور في عالم الناس الشهادة.
لكن من أين جاءت النفس؟ وما علاقتها بالبدن؟ وما هو مصيرها في الأخير؟
جميع هذه الاستفهامات تبقى غامضة في تصوّر ابن سينا. لذلك فإن قصيدته تشفّ عن احتمالات متردّدة. فقد فسّر وجود النفس بالتعويل على البرهان الطبيعي وعلى مبدأ الحركة القسرية الناتجة عن دفعة خارجية تصيب جسما فتحركه. في حين أن نقيض الحركة في حق النفس البشرية، حركة مضادة لقوانين الطبيعة. وهو ما استلزم مُحركا زائدا على عناصر الجسم، هو في منطق ابن سينا دائما النفس تحديدا. فالإنسان يستطيع تجاوزا للحيوان اظهار التعجّب والانفعال ضحكا وبكاء. وهو يصوغ أحاسيسه بالتعويل على الكَلَمِ وباستعمال الرموز والإشارات وإدراك المعاني المجرّدة واستخراج المجهول من المعلوم، وجميعها أفعال وأحوال تخصّه حصريا، ليست في نظر ابن سينا دائما راجعة للبدن، بل إلى قوة مستقلة، تخصّ النفس حال تصرّفها في أجزائه، "فهي فيه واحد، بل هي هو بالتدقيق."
هذا التشابك بين مختلف العناصر المعرّفة للأنفس، هو في تصوّرنا ما احتفظ به مؤلِّف روية "الأوج الفسيح"، عامدا إلى إقامة رابطة بين مثلثه الخائض حصريا في جواهر النفس والروح، وسداسييه النازل إلى أديم، أوشك تجبّر بني البشر على الاخلال بالشروط الضامنة لبقاء الحياة فوقه. فقد شيّد كمال الهلالي عرض روايته على ستة أضلع، تطابقا مع صندوق التعسيل حال عودة ثول النحل للهَجْعَةِ. وحملت حمل تقطيع مواقيت مرويته في تسريدها تسميات شقّت ضمن الضلع الأول برزخا لالتقاء الأموات بالأحياء: "أحدهم يحلم بنا"، وكشفت في ثاني الاضلع وثالثها، عن خلاء مواضع العبادة ومزارات التقاط البركة: "مسجد فارغ"، و"مزار فارغ". في حين حاولت ضمن بقية الاضلع رسم وقائع تراجيدية لاستحالة العيش وتكدّر زمن الغبطة الأولى في تعقّب حكاية تدمير طفولة "نور" البريئة وسيرها الـمُذهل نحو حتفها الاختياري، لولا ما أحاط بطفولتها البريئة من ألطاف خفيّة. لذلك بدا لنا انقلاب النسق الوديع للحياة بعد أن نغّصته شرور المتحصّنين من السلفيين الناسلين عن "شتلة أخرى" أو "فولة واحدة"، هو الذي أفرده كمال الهلالي بالسرد، عارضا علينا توصيفا بديعا لجنة دنيوية أزلية ظنّنا معه أن عِقدها غير قابل للانفراط، لولا قسوة الأقدار المروّعة وتصدّع إيكولوجيا التوازن حال نفور أُمّة النحل إلى مراقي الجبال، ونزول ستار آخر المشاهد على انتزاع الغربان والوحوش والسوائم ميراث جنات تفاقمت هشاشتها بعد أن أصابها عنت اجتماع البشر وأرزائه، في مقتل.
حديث البرزخ:
يشكل البرزخ جغرافيا حاجز فاصل بين شيئين مختلفين يمنع اختلاطهما أو امتزاجهما. بيد أنه اتخذ دلالة غيبية بمجرد ورود تلك اللفظة في سورة المؤمنون الآية 100، إشارة إلى العالم الفاصل بين الموت ويوم القيامة. فقد جاء ذكر البرزخ في القرآن في ثلاث مواضع. اثنان بمعنى أرض ملموسة على شاكلة ما حملته سورة الرحمن (الآيات 19 إلى 21): "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان". وكذا الأمر ضمن الآية 53 من سورة الفرقان "وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا." أما ثالث المواضع، فيدل على عالم غيبي غير ملموس، وفق ما جاء ضمن سورة المؤمنون (الآية100): "لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون."
لذلك أصرّ كمال الهلالي منذ انطلاقه في رسم وقائع الضلع الأول من روايته على حقيقة مُربكة تحيل على قدرة الأزمنة على الانزلاق في بعضها البعض. فقد انطلق ترتيب أحداث المروية بزعمٍ مَفَادُه أن: "أحدهم حلم بكل [شخوصها]. نبتوا في حلمه، ثم انفصلوا عنه وصار لهم غيب وغياهب. " (الأوج...، ص 11).
بدأ هرج الانتفاضة بعد أن قلب الثوار تابوت قبر أبي زمعة البلوي بالقيروان، فاتسعت رقعة العصيان مثل النار في الهشيم. وتواتر تلك الهزة التي اقضّت مضجع سلالة متهالكة مع تفشي الوباء واتساع دائرة الجوع والخصاصة، الشيء الذي أدى إلى حصول َنوَسَان مُربك في دورة الزمان، بحيث انقلب السرد إلى صياغة حالة من التناظر الغريب بين ما عاينته تلك الآفاق زمن ثورة القبائل ضد مخزن الحسينيين تونسيا بزعامة علي بن غذاهم خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبين ما حصل للبلاد إثر هروب الرئيس الأسبق للتونسيين زين العابدين بن علي إلى منفاه الاضطراري، فخروج "إسلام الصحوة" من زاوية ميّتة واستبداده بالمشهد السياسي، قبل أن تُرزي به فجيعة الجائحة الكونية.
عندها عمّ الفراغ واستبد الهلع بالساكنة فـ "... خَلًتْ القرية من أهلها. [ولم يعد الجميع] يعرف ماذا سيصنع بحياته ... قوافل الفارين الذين ... كانوا يمشون صامتين... خليط من الرضا والانكسار العميق والتسليم ... يبدو في نظرات[هم]. بعضهم يهيم في البراري بحثا عن قرية آمنة ... وبعضهم قد تشوّش عقله ... بعضهم يتكوّر ويحضن عصاه وينام مُكثِّفا رغبته في ألا يصحو إلا على الموت ... كل شيء في [هذا المشهد] أجزاء مقترنة بعضها ببعض، كقرآن حيّ يستمد نَفَسَهُ ... من دوّي المجرات البعيدة. كل شيء، الأشجار، والنجوم، والليل، والنهار، مصبوغة بهذا النَفَسِ الحار، حتى أنه لا يوجد موت. لا شيء يذهب خارج الكون. عظام الموتى تبقى هنا وتبلى هنا، في مظانِّها بالأرض." (الأوج...، ص ص، 20 - 21 و35.)
الغراب، وطائر السويدة، والنحل، والصرصار، والقوبع، والحمار، والفرس، والبغلة.
الأب المؤسس للفصيل عِماره، وعمّار، وعيّه الطاعن في السن، والناجي، والرزقي، والحُسين، والحبيب، وصابر، ومصطفى، وعبد الرزاق الأعمى، والطيب، والشيخ صالح، وحفصة، وتومية، وهنية، وبركانه، ومباركة العمياء، والزهرة، وعيشة، وخدوج، وجنات العانس، وفاطمة الجدة وحفيدتها الحاملة لذات الاسم، وغيرهم(هن) كثير ممن خاضت في تعاريج أقدارهم(هن) حكايات منسوجة بتدبير وحذق. جميعهم احتلوا "برزخا ما [بين الحياة الموت] فمن جهة ما [هم] أحياء، ومن جهة أخرى [هم] موتى" (الأوج، ص30).
"سراب الأطفال اللذين يجاهدون أنفسهم في التخلّص من حبالهم، يَشِعُ من عيونهم أسى وكآبة معديين، هو الذي لَحِقَ بالناجي، ذاك الذي قَضَى في سن الطفولة الغضة جراء ما أصابه من عجيب الحمى، طامحين في مقاسمته ما جمعه بمظلة أبيه من لذيذ التوت. ارتعب "لما فكر أنهم موتى بلا سبب واضح". " كان يخال أنهم ذاهبون لعقل حيواناتهم" لأنه لم يكتنه "ما حدث طالما أنه لم يعرف في زمانه خبرة أن ينتحر طفل...[لذلك] غمرته كآبة طفل فسد فرحه بما قنص." (الأوج، ص 26 -27).
تلك سياقات كسرت فواصل زمنية سحيقة بين الأجداد والحفدة، لتقيم علاقة مربكة بين الحاضر والما مضى. ففي تعمُد الخلط بين الأزمنة تأصيل لفكرة القصّ والتسريد، بدا لنا أشد مضاء مما قد يُوحي به تشويش تتداخل الأزمنة حال الـمُضِيِّ في التعرّف على تلافيف الحكي.
فقد فضّل من هندس أحداث الرواية وحال استحضار فواجع انتحار الصبية، اختصار مهابة الخَطْبِ بالتعويل على تقنية الإيماء عرضا لحادثة نزوق الأطفال وملاحقتهم للناجي طمعا فيما قطف من شهي ثمار التوت. وهو عين ما قصدَه حال الإشارة إلى خَرَفِ "عمر" وارتكابه لمحظور شنيع، بحيث تم وصل ذلك تخفيفا بخديعة ابنته جنّات المتنكّرة في ثياب أمها خدوج، ترفّقا بمشاعر والدها، الذي ابتاع لها من السوق بعد أن أفلح في بيع عجلته النطوح "كساء داخليا ناعما، مع لُبان، ومُشط من العاج وحلوى شامية"، ما كان ينبغي عليه أن يُهادي بها غير زوجته، التي بدا ذاهلا بالكامل أنها قد قَضَتْ منذ بعيد الآماد.
في حديث البرزخ تداخل بين ما فرط من الأزمنة وما هو بصدد الحصول. وَحْدَهَا تراجيديا الفراغ على الحقيقة، قد شكلت عنوان جميع تلك اللحظات المكثفة، التي اختار المؤلِّف تصويرها بتحفّظ وأناة، مع ترفّقٍ في نسج ساحر البيان.
تراجيديا الفراغ
شكّل كمال الهلالي برفش رسام ماهر وعلى مدى الضلعين الموالين من روايته عالم ساجر في طمأنينة وديعة اخترق شاسع الأزمنة، قبل أن ينفجر قديمه والأليف. عندها "جدت أشياء ما كان يجب أن تجدّ أو أن تجُبّ ما قبلها ... فقد استبدّ أهل السلف بالإمامة، وتعاظم وقع حوادث انتحار الصبية ... وفرغ المسجد من المصلّين، ونزح ناس القرية عنها. فاعتبر السلفيون المسجد ضِرَارًا مليئا بصلوات القدامى وروائحهم ... تراب، وطلْع أشجار، وأغلفة رقيقة لحبات القمح والشعير، وبَعْر، وصنوبر غابي، وشذي أزهار بريّة عالقة بالأغنام، والخيول، والبغال، والاحمرة، والمعز."
بَادَ ذلك العالم الوديع بالرمّة، وغار كما تغور مياه الينابيع في غابة زرعها الدواعش بالألغام وبثقيل خطاهم أيضا. توحّش الحيوان ولاذ بالأحراش البعيدة بحثا عن بركة مفقودة أو تسبيح مهيب. لو نَطَقْت الأنفس لاستذكرت أن أمر ذلك مُعلَّق بـ "نبض حيّ، ممتلئ بشيء مختلفٍ لا اسم له ولا صفة، "هُوَ ما هو..." إحساس غامر لا جوع يعتور سكينته ولا نَصَب. بدّد الزمان الحزين أجزائه واستبد به "خوف حَجَبَ كل نبض إنساني ليُفقده براءته الأولى... " (الأوج...، ص 39 - 80).
تَعْرِفُ الروح التي تسكن الغابة ما ينقص القرية حتى تعود إلى سالف إيقاعها وصِلاتها الحقيقية. غير أن "رهطا غريبا من البشر، له رائحة حيوان لم تغسله مطر الله"، هو من أورث ذلك العالم الساجر في هدأته تصاريف فاجعة، اغتَال بدم بارد بالتعويل على تخاريفها، القريب قريبه، والأخ أخاه، مُحتسبا في حقه بجريرة الانتماء إلى "الطاغوت"، والحال أن يأسه من أن يكون له نفس الحظ في الخدمة، هو ما أوغر قلبه وأغراه بسفك دمه على الحقيقة.
أربك حضور العساكر لملاحقة للمسلّحين المحتمين بمفاوز الجبال قلوبا نظيفة، وقطع على سكان القرية رِزقها الذي كان يأتيها رغدا، فانتشر بالساحة المحيطة بمزار الصلاح عند "سيدي غريب" أشقياء قلبوا تراب رمسه بحثا عن الكنوز، قبل أن يزرعوا ألغامهم بحَرَمِهِ وعند مرقده أيضا، وذلك بمجرد أن اعتملت في أعماقهم نوازع مضطربة، هي إلى الغضب والحسد والشهوة، أقرب من ادعاء تطبيق أحكام الله وشرْعَته.
كان يكفي أن يعمّ ذلك الفراغ الـمُخيف، حتى ينغّص على الصبية أحلاما لم تبرح مربّع الغبطة الأولى، فتُعشِش الكوابيس المميتة في مخيلتهم وتُفسد عليهم نشوة ترمح لاهية بين أعالي وأسافل، فتشُد أرواحا بريئة لمطالع النجوم والكواكب البعيدة المعلَّقة في السماء، على شاكلة ثريا ازدانت بمصابيح تُنير دروب الثرى، مُجلية ظلمتها الدامسة.
درب التبانة
في مأثور كلام العرب يُحيل درب التبانة تشبيها على ما يسقط من التبن الذي كانت تحمله المواشي، والذي كان يظهر أثره على الأرض كأذرع ملتوية تشبه أذرع المجرّة، باعتبار أن جزءا منها يُرى في الليالي الصافية كطريق أبيض من التبن ويتمثل للرائي بسبب النور الخافت الممتد في السماء على ذلك الشكل، نتيجة لملايين النجوم السماوية المضيئة هناك.
وعند متابعته لأقدار الطفلة "نور"، أفرد كمال الهلالي ضلعا بحاله، وشكل قبس مُتوهِج، ونِثَار من الضوء صاغه الروائي بشاعرية لا تقاوم، حتى وإن اقتربت طريقة السرد إلى نشيج صامت ضارعت مشاهده مأساة إنسانية مَهِيبة. فقد ساعفت مختلف المشاهد التي تدبّر المؤلِّف استحضارها بحذق، تعقُب ما اعتمل في خُلد صبية في مقتبل أيامها من اضطرام للأحاسيس وتباين للنوايا.
ألم يكن "الحصان لابثا في مربضه ثملا من شدة الحرّ بفؤاد فارغ"، بينما كانت الحيوانات سائبة متوحِّشة في البساتين المهجورة. عندما هامت "مباركة العمياء على وجهها كبغلة سائبة...تنام وحيدة بلا أحلام ... يؤذي باطنها لسع الوحدة".
"ناعسا، رفع الحصان رأسه نحو القمر المكتمل". فهو لا يرى في تشكيله الداكن طفلة شنقتها الملائكة من ضفائرها بعد أن نزقت عن نواهي والدتها.
لا مراء في أن الصمت الزائد عن حدّه والفراغ الهائل المحيط بالقرية هو الذي تسرّب إلى أعماق نور الصغيرة، فحرّضاها على وضع نهاية ذلك الأسى الذي اصطبغت به أيامها ... وهي التي لم تعد تعرف في أي قسم تدرُس بعد أن حُشرت ضمن عشرين تلميذ، انتحر أربعة منهم في مدرسة تفصِلها عن القرية خمسة عشر كيلومتر بأكملها.
"ثمة بعد تجاوز غابة الصنوبر بساتين ممتدة وسهول وجبال وطيئة، وسماء فسيحة جدا..."، غير أن الأسى الذي وَقَرَ في صدر الصبية هو ما كدّر روحها. فقد انتظمت وقائعه المروِّعة في سلك جارح، ليترك وجعا غائرا في أعماقها. نظرات أختها السادرة في نوباتها الهستيرية، وطعم ثمار شجرة الاجاص الحامض والمرّ التي كانت تتبول تحتها ليلا. وحده مشهد الضوء المنبعث من درب التبانة هو الذي بدد قليلا من وحشة الطريق إلى بيت والدها. فقد استبدت بخاطرها "خبائل حكايا الأطفال المنتحرين"، كما فظاعات ما يأتيه الكبار من تصرفات مُـخْزِية.
هول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هو ما اقتادها كُرهًا إلى لف الحبل المعقود على رقبة الحصان عند شجرة الاجاص في ليلة اكتمل قمرها. نور التي لم تركب حصانا أبدا، كانت تشتهي فعل ذلك لترقى عاليا في الأوج الفسيح ... شيء مهيب في هدوء الليل وفي ضمير الكون يقول لها أنّ عطيّة جميلة تنتظرها. "كلّ القلق الغامض الذي أمسك بها، كلّ تلك الأجزاء المبدّدة من الحبور، وهي تمرّ بمنازل وبساتين أليفة ... تتكتّم على جلال وعلى أسرار لا تدري ما هي، كان يعتمل في باطنها، فيشكّل مجرّات من الأحاسيس تطُوف في مدراتها، وتُشعرها بسكينة تتسرّب إلى روحها.
وحدها لحظة التماس المشوبة بلُطف خفِيّ، هي ما أجبرها إلى التراجع وفي آخر لحظة عمّا انقادت إلى اتيانه. فقد "ابتعدت في مهاوي عميقة في كونها الداخلي، متأمّلة لطخات الضوء في السماء، ليتسرب إلى روحها وهي تتأمل درب التبانة شعور غامض ... كان نور القمر جميل، بينما كانت الصبيّة تستعد لقتل نفسها... ارتعبت مما كانت ستأتيه مُستشعرة بسبب كمال الدائرة الفضية المحيطة بالقمر، صدّا حنُونا ردّها عن اقتراف المحظور وزهق نفس حرّمت جميع الشرائع قتلها. نزعت الحبل من الشجرة وقرّرت أن لا تبول تحتها مستقبلا، لعل ثمارها القادمة لن يفسد طعمها." (الأوج...، الضلع الرابع "نُور" صفحات 87 - 110.)
"...أَعَجِزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب..."
ضمن الضلعين الأخيرين الخامس والسادس، يعرض كمال الهلالي بأناة العارف بمقصده إلى حادثتي اغتيال "الحُسين" من قبل رهط من السلفيين المتحصنين بأعالي الجبل، قبل أن يتوسّع وفي الضلع الموالي ليسرد على قرّائه تفاصيل حادثة تصفيّة "الحبيب" المنظمّ إلى الدواعش من طرف جند الكتيبة العسكرية الملاحقة لهم، بعد أن زهق هو إفكا وعدوانا روح ابن خالته وأخيه بالرضاعة "صابر".
فقد طوّحت بنا تفاصيل الحكاية بعيدا مستجلبة وقائع حلول ثلاثة نساء بمقبرة القرية، وَفَدَ جميعهن من بعيد ليشكّلن نَفْسا واحدة تفرعت عنها ثلاث أنفس قادمات من أزمنة الذكرى والحلم، واحدة منهن طاعنة في السن على حدّ ما روته "جناة" الـمُشرفة "على عتبات الجنون" لـزوج الجدة فاطمة "عيّة"، هو الذي كان يعيش "بلا عمر في البرزخ الذي يفصله عن الموت [متحرّكا] ببراءة من اختبر أن أجزاء العالم المبدّدة ينظّمها مبدأ كليّ غامض حيّ مِثْلَهُ"، أما الأخريات فالظاهر أنهن أتين من "القيروان البعيدة عن مكة، الواقعة عند مساكن الجنّ"، لم يبلغن كهولة العجوز، بحيث لازلن بين أوج وصِبَى، حتى وإن نسلن من "فولة واحدة".
مجيء النسوة المتشابهات من القيروان لمقبرة القرية، هو ما استحث الحُسين على زيارة قبر والده، مُساهما في استذكار سنوات صباه، لما اعترضه ذلك الحُوار السارح هانئا بين القبور. ضمّ الحُسين صغير الجمال النَزِقِ إلى قطيعه، ولم يكن يدري أن اقتفاء أثر توغله بالغاب هو ما سيتسبّب في دقّ عنقه من قبل السلف المتربص بمن يقترب من مخابئه. وهو أيضا ذات ما أورث في أعماق قريبه "مصطفى" خال "الحبيب" و"صابر" وابن عم "الـحُسين"، ندما عميقا، جراء تورّطه في دماء أقربائه، والتفكير في الهروب من قساوة ما اقترفه هذا الرهط الشنيع من البشر، والانخراط في "كون الغابة الساجر بأصوات الليل جرْيًا على السُنن الخافية، تلك التي يمسك بمقاليدها إله البراري البعيدة." (الأوج...، ص 111 - 134).
يرتبك نظام الغاب بالكامل في الضلع الأخير من الرواية لـما لم يعد يسعه احتماله. فقد انفطر قلب "عيّة" الهَرِمِ بعد أن أصابه نفور ثول نحله إلى أعالي الجبل في مقتل، بينما كانت زوجة الـحُسين "غزالة" سادرة في حِدَادِها الحزين، تواسيها زوجة "عيه" فاطمة، تلك التي كانت بدورها نهبا لسوانح شتى، حتى وإن اطمأنت إلى أن من اغتيل غدرا وقتل صبرا قد انتقل إلى "برزخ يقع بين المرئي واللامرئي [حيث] لا وجود للموت" (الأوج...، ص 137)
تريد زوجة "عيه" أن تمرض حفيدتها مرضا خفيفا حتى لا تزورها، فلا يصدمها انتحار رفيقاتها في اللّعب. تريد أن تروي لها حكايات مُبهجة وسعيدة عن أعراس، ونوارج، ومطامر ملآى بالحَبِّ والحُبِ. تبتغي أن تقصّ عليها حكاية عن طائر السويدة، ذلك "الجزء من كليّة الكون... الذي تفترق الأجزاء وتقترن في فؤاده"، عن اصراره على الامساك بغيمة، حَوَّلَها سراب الرؤية في ناظريه إلى قطعة صوف بهيّة استملح نسج عُشه من خيوطها. لن يكتمل القصّ إلا بحضور غُراب فاحم السواد، يحمل نفس نعومة شعر حفيدتها، مع حلم مثير تزهو له الروح وتهتز له أعضاء الصبيّة. بيد أن كل عالم الجدة قديم، ولم يعد يُجدي نفعا، بما في ذلك ما تعوّدت على ترديده في خُلدها من صلوات وتعاويذ.
فما أن تعقّبت عينها السارحة في أضغاث حلمها الجميل حقيقة صعود الغراب إلى أوجه، حتى أذهلها محلُّ الخَطْبِ في محاولة حجب السلف جريرة حزّ عنق الحُسين. ألم يـ "بعث اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ [أي قابيل] كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ [هابيل]. قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ [المائدة:31].
قابيل وهابيل مجدّدا، أبدا، أزلا. راعي الغنم، في مقابل المزارع، ثمار الأرض إزاء سِمَانِ الغنم. لمن ستُبشّر السماء بقبول القُربى هَدْيًا سال دمه في مرضاة المشيئة. تنقية لإيمانه قدم هابيل ذبيحته إلى الرب لتشهد له المشيئة بالبِرِّ، في حين لم تهب لقابيل ما به يستطيع تنقيّة إيمانه وتصفيّة سريرته. لمثل هذا ولأقل منه أيضا، زُهقت أرواح وقُتلت أنفُس. فاستشاط الرب لذلك غضبا، متوجها بسؤاله للجاني: "أين أخوك؟ قال لا أعلم؛ أَحَارِس أنا لأخي!؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ من الأرض. فالآن، مَلْعُونٌ أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك. متى عملْت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائهاً وهارباً تكون في الأرض."(العهد القديم).
ألم يترك قابيل أخاه ملقى في العراء، مُعرَضاً للهوام والوحوش، فخرج من ساعتها غراب يحفر في الأرض حفرة. فلما رأى ذلك، استشعر الجاني نقيصته الآثمة ولام نفسه الأمّارة بالسوء معاتبا: "كيف يكون الغراب أهدى مني سبيلاً؟ "يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ...[ـه] فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي." (سورة المائدة)
سلّط كمال الهلالي في بديع ما رواه نظره الثاقب على النفس الإنسانية وما تستعرُ به من عواطفَ ومشاعرَ وخيالات، خارجا على سلطان العقل أحيانا، جانحا إلى سلطة القلب، مستفيدا من معاني الكُتب المقدّسة ومن فصُوص أدب التصوّف الـمُترعة قصصا ونماذج ترسم عالم يقوم على معاني الخير والحقّ والعدل، كما التمرُّد على قوانين المجتمع وأنظمته وقواعده، مع الشغف بالطبيعة والالتجاء إلى ما فيها من بهاء وعظمة وخلود، وتعويل على فكر جريء يُعيد اكتشاف العالم ورصد مفارقاته، والميل إلى الحدس أكثر من التفكير، والتركيز على قضايا إنسانية أليفة في بساطتها، عظيمة في مدلولها، والانصات إلى نشيج حزين لا يمكن أن لا يذكُـرنا بصراع النفس في محاولتها الإفلات من قفصها الطيني، ومن تفاهة حياة مُطلّة على نافذة فناء محتوم./.