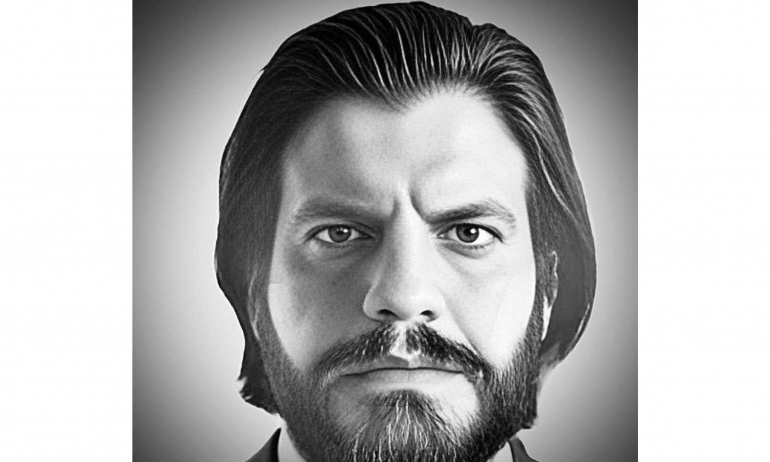واقية في وجه الأزمات الجيوسياسية. غير أن الصراعات الأخيرة، كالحرب التي اندلعت على مدى 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في جوان 2025، أو الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فيفري 2022، تطرح علامات استفهام عميقة حول جدوى هذه التحالفات. أين كان حلف «الناتو» من أوكرانيا ؟ ولماذا بقيت روسيا، رغم توقيعها اتفاق شراكة استراتيجية مع إيران يوم 17 جانفي 2025، تكتفي بالمراقبة أثناء الضربات الإسرائيلية على طهران؟ وأين موقع الصين، الحليف الاقتصادي الأكبر لإيران وعضو مجموعة «بريكس»، في هذه اللحظات الحرجة؟
تبدو هذه التساؤلات انعكاساً لأزمة أعمق، أزمة في جوهر التحالفات نفسها. فبينما كان يُفترض أن تشكّل أداة لضبط التوازنات، باتت اليوم تتلاشى أمام عالم تتقدم فيه الحسابات الاقتصادية والرهانات الجيواستراتيجية على الالتزامات العسكرية الصارمة. لم تعد التحالفات تُطلق تأثيراً شبيهاً بالدومينو كما كانت تفعل في الحقب السابقة، من العصور الوسطى إلى الحرب العالمية الثانية، بل أصبحت تتأرجح بين مواقف رمزية، وتنسيق اقتصادي، وتخبط استراتيجي في مشهد دولي شديد التعقيد.
رمزية التحالفات: حين تتحول السياسة إلى استعراض
أصبحت العديد من التحالفات المعاصرة أقرب إلى البيانات الإعلامية منها إلى الالتزامات الحقيقية. يتجلى هذا الأمر في الاتفاق بين روسيا وإيران في جانفي 2025، الذي رُوّج له كتحالف يعزز التعاون العسكري والاقتصادي ويشكّل توازناً في مواجهة الغرب. ومع ذلك، فضّلت موسكو، رغم هذا الاتفاق، التريث والوقوف على الهامش خلال النزاع الإيراني-الإسرائيلي في جوان 2025، معتمدة على دور الوساطة الدبلوماسية بدلاً من الانخراط العسكري المباشر. ويُعزى ذلك إلى حسابات روسية دقيقة، أبرزها الانشغال بمستنقع أوكرانيا.
وينسحب الأمر ذاته على مجموعة «بريكس»، التي توسّعت في 2023 لتضم كلاً من إيران، مصر، الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى جانب الأعضاء المؤسسين: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا. رغم طموحاتها المعلنة بتحدي الهيمنة الغربية، خاصة عبر مشروع «إزالة الدولرة»، لم تتجاوز مواقفها خلال قمة «تشينغداو» في جوان 2025 عبارات عمومية عن «خفض التصعيد»، من دون أي التزام عسكري تجاه طهران.
في هذا السياق، تبدو التحالفات بمثابة ظواهر جيوسياسية استعراضية – أدوات لاحتلال موقع في المشهد الدولي أكثر من كونها أدوات للفعل. وكما أشار المحلل روبرت مالي (Robert Malley) ، فإن ازدواجية المعايير لدى القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، تُتيح لحلفائها – كإسرائيل – تجاوز القانون الدولي دون عقاب، في حين تُترك الأطراف المعادية – كإيران – في عزلة حتى وإن وقّعت شراكات استراتيجية.
تحالفات اقتصادية أكثر منها عسكرية
لم تعد التحالفات الدولية تقوم على التزامات عسكرية كما كانت في القرن العشرين، بل صارت تُبنى على أسس اقتصادية تُراعي منطق المصالح. فالصين، التي تشتري أكثر من 90 ٪ من النفط الإيراني، توفّر لطهران شبكة دعم اقتصادي مهمة، لكنها ترفض أي تدخل عسكري يمكن أن يجرها إلى مواجهة غير مباشرة مع الولايات المتحدة.
أما روسيا، والتي تعتمد على المسيّرات الإيرانية في حربها على أوكرانيا، فإنها تكتفي بتزويد إيران بأسلحة دفاعية محدودة، بينما تواصل تطوير شراكات طاقية مع دول كالهند والسعودية في إطار منظمة «أوبك+». هذه التداخلات تؤكد أن العالم اليوم محكوم بتشابكات اقتصادية تعرقل نشوء تضامن عسكري حقيقي.
حتى حلف الناتو، ورغم تعزيزه منذ بداية الحرب الأوكرانية، اقتصر دوره على دعم غير مباشر لكييف، عبر إمدادات السلاح والعقوبات، مع تجنب أي مواجهة مباشرة مع موسكو.
هذا التوجه أفرز مواقف متناقضة. ففي عام 2025، قامت واشنطن بإعادة توجيه 20 ألف صاروخ مضاد للمسيّرات، كان من المفترض أن تُرسل إلى أوكرانيا، لصالح إسرائيل. وهو ما يسلّط الضوء على تنافس محموم على الموارد الدفاعية الغربية، بل وعلى تراجع أولويات الحلفاء بحسب تغير خارطة التهديدات.
أما إيران، ورغم تقاربها مع روسيا والصين، فقد تُركت وحيدة في مواجهة الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقعها النووية في جوان 2025. واقع يبيّن أن التحالفات، التي يُفترض أن توفّر مظلة حماية جماعية، باتت تتركّز على تعاون قطاعي محدود، غالباً ما يكون اقتصادياً، ويغيب عنه الانسجام الاستراتيجي.
ارتباك استراتيجي في عالم متعدد الأقطاب
يشهد العالم المعاصر تعددية قطبية تجعل من الصعب تشكيل تحالفات ثابتة. الدول، بدلاً من الاصطفاف وراء تكتلات صارمة، تتبنى استراتيجيات مرنة تتيح لها المناورة بحسب السياق. فتركيا، على سبيل المثال، عضو في حلف الناتو، لكنها تحافظ على علاقات تجارية مع روسيا، وتتابع مصالحها المستقلة في الملف السوري.
الهند، وهي عضو في «بريكس» و»كواد» Quadrilateral Security Dialogue) منتدى استراتيجي رباعي يجمع بين أربع دول: الولايات المتحدة، اليابان، الهند، وأستراليا (، تمتنع عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل مباشر، حفاظاً على توازن علاقاتها مع كل من موسكو وواشنطن. هذه السياسات تعكس مشهداً عالمياً مرناً، تُعاد فيه صياغة التحالفات باستمرار وفق منطق البراغماتية والنجاة السياسية.
تجسّد هذه الظاهرة تحالفات جديدة مثل «أوكوس» (أستراليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) الذي يركّز على أهداف محددة، مثل تسليح أستراليا بغواصات نووية لمواجهة الصين، أو الاتفاق الصيني-الإيراني الموقّع عام 2021، الذي يتمحور حول مشاريع اقتصادية مثل «طريق الحرير»، من دون التزامات عسكرية.
وكما يشير المفكر برتران بادي (Bertrand Badie) ، فإن تدويل النزاعات يجبر كل دولة على إعادة تموضعها بشكل دائم، مما يجعل النماذج التقليدية للتحالفات شبه متجاوزة.
هل انتهى مفعول «الدومينو»؟
كثيراً ما تحوّلت التحالفات على مدى التاريخ إلى محرّك لتوسيع رقعة الحروب. الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، انطلقت من خلاف محلي بين إمبراطوريتين، لكنها اتسعت بسبب تفاعل تحالفات: «الوفاق الثلاثي» و»التحالف الثلاثي». وينطبق الأمر ذاته على الحرب الكورية (1950-1953)، التي بدأت كصراع داخلي، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مواجهة دولية بين معسكري الحرب الباردة، حيث دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الجنوبية، بينما وقفت الصين والاتحاد السوفييتي إلى جانب كوريا الشمالية.
أما اليوم، فيبدو أن هذا المنطق يتراجع. الحرب في أوكرانيا لم تدفع الناتو إلى التدخل المباشر، تجنباً لمخاطر التصعيد النووي. وحتى الحرب بين إيران وإسرائيل بقيت محدودة النطاق، رغم مشاركة أمريكية في قصف مواقع نووية إيرانية.
ويبدو أن هذا التراجع في فعالية التحالفات لا ينبع من غياب الإرادة فحسب، بل يرتبط أيضاً بعوامل أعمق. إذ يعود هذا الانكفاء إلى تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية، مما يجعل من الصعب على الدول المجازفة بتورط مباشر قد يهدد استقرارها الداخلي أو مصالحها الحيوية.
روسيا، على سبيل المثال، تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع بعض الشركاء العرب مثل السعودية، التي تمثل شريكاً محورياً في تحالف «أوبك+» للطاقة، ما يتيح لموسكو تخفيف أثر العقوبات الدولية وضمان استمرار صادراتها النفطية، فيما تسعى الصين إلى تجنب التصعيد مع واشنطن حفاظاً على تدفق تجارتها العالمية. كما أشار تقرير «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن القوى الكبرى باتت تدير الأزمات بمنطق الاحتواء والتطويق، لتفادي الانجرار إلى نزاعات عالمية لا يمكن السيطرة عليها.
تحالفات مرنة في عالم متشظٍ ومبعثر
لم تعد التحالفات الدولية كيانات صارمة كما كانت في الحرب الباردة، بل تحوّلت إلى أدوات مرنة تستجيب لحسابات آنية، تارة اقتصادية، وتارة رمزية. صحيح أنها ما تزال تلعب دوراً مهماً في زمن الترابط العالمي، لكن فاعليتها باتت محدودة بسبب تضارب المصالح الوطنية والخوف الدائم من فقدان السيطرة على مجريات الأمور.
الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل، والعزلة النسبية التي تعيشها أوكرانيا، وتردد دول «بريكس» في الانخراط الجاد، كلها مؤشرات على عالم تحكمه استراتيجية التردد، لا منطق التحالفات المتماسكة. ومع تسارع تفكك الأطر التقليدية، ربما بات المعنى الحقيقي لأي تحالف اليوم هو القدرة على التكيّف والتعامل بواقعية مع عالم متشظٍ، حيث لم تعد الصداقات دائمة، ولا العداوات نهائية، وحيث أصبحت كل شراكة مشروطة بإمكانية الفكاك منها عند أول عاصفة.
بقلم: أمين بن خالد محام ودبلوماسي سابق