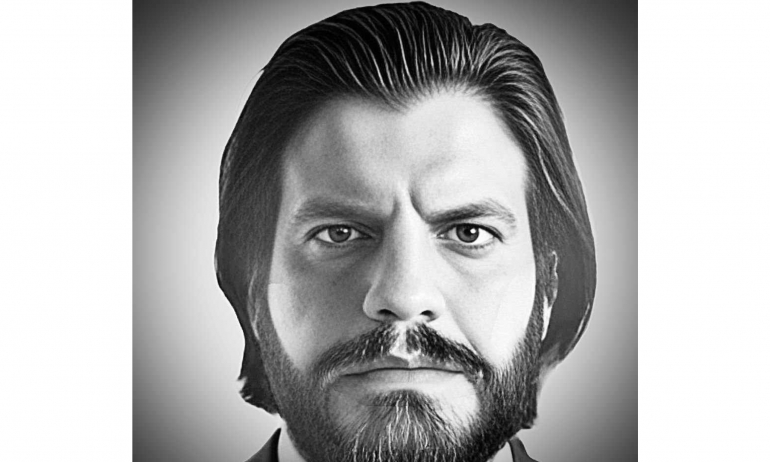قد أقصي اليوم إلى مرتبة الأسطورة أو العبارة البلاغية الجوفاء. فعلى المنابر الدولية، تردّد الكلمة بنبرة باهتة، وكأنها تنتمي إلى مفردات عصرٍ مضى، حين كانت النزاعات لا تزال تجد مخرجًا سياسيًّا. ومع تفشي وحشية الحروب المعاصرة وتصاعد منطق المواجهة الدائمة، فقد السلام شيئًا فشيئًا قدرته التعبوية. وبات يُنظر إليه لا كقيمة جامعة، بل كموقف مشبوه، بل ومخزٍ أحيانًا، إذ يُساوى بالهزيمة أو التنازل أو الضعف. في هذا السياق الجيوسياسي الراهن، حيث تسود القوة على القانون وتطغى الواقعية السياسية على “المثالية الويلسونية” (نسبة إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي دافع عن نظام دولي قائم على القانون، والديمقراطية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها)، يحق لنا التساؤل: هل لا يزال بوسعنا التلفظ بكلمة "سلام" دون أن نُقصى أو نُستبعد من المعادلة السياسية؟
لا تعود هذه الإزاحة الدلالية إلى الصدفة، بل تعبّر عن تحول عميق في المخيال السياسي، حيث باتت الحرب الشكل "الطبيعي" لتسوية النزاعات. فهذه المأسسة للعنف ليست عارضًا من عوارض التاريخ، بل تكشف مأزق نظام دولي يقوم على الهيمنة والتنافس بدلًا من التعاون والعدالة.
أولًا: اختفاء السلام من الخطاب السياسي السائد
لقد تعسكر الخطاب السائد في العلاقات الدولية بشكل لا رجعة فيه. في بيانات القوى الكبرى، وتحليلات الأمن، وردود الأفعال الإعلامية، أصبحت الحرب أفقًا مشروعًا، بل مرغوبًا فيه. هذا التحول اللفظي ليس بلا دلالة: إنه يكشف عن انزياح خطير في المفهوم السياسي، إذ لم يعد الآخر خصمًا يمكن مجادلته، بل عدوًا لا بد من استئصاله. لم نعد نتحدث عن نزع السلاح، بل عن الردع؛ ولم نعد نذكر الدبلوماسية، بل نُسرِع إلى "الرد". شيئًا فشيئًا، حلّت "الضربات الوقائية" محل "المساعي الحميدة"، كما أزاحت "العقوبات" الحوار من موقعه الطبيعي. وهكذا، لم يعد السلام يُنظر إليه كغاية استراتيجية، بل كهدنة مؤقتة بين دورتين من العنف، توقف تكتيكي لا أكثر في سياق صراع دائم. هذه اللغة المفعمة بالحرب لا تقتصر على المجالات الأمنية والعسكرية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الحقول الاقتصادية، حيث تغزونا استعارات من قبيل "الحرب التجارية"، و"معركة العملات"، و"غزو الأسواق". وبذلك، لم يعد الخطاب وسيلة لفهم الواقع أو تهدئته، بل تحوّل هو ذاته إلى ساحة معركة رمزية، يُعاد فيها إنتاج التوتر بدلًا من احتوائه.
يترافق هذا التسلح اللغوي مع جمالية للعنف (esthétique de la violence) تعود جذورها إلى ما سماه والتر بنيامين (Walter Benjamin)"جمالية السياسة" في الأنظمة الشمولية. الإعلام المعاصر، الأسير لمنطق الفرجة كما وصفه غي ديبور(Guy Debord)، يُحوّل كل نزاع إلى مسلسل جيوسياسي، فيفضّل العاطفة على التحليل، والآني على المتراكم.
في الفضاءات الإعلامية، ينصبّ الاهتمام حصريًّا على النزاعات الجارية، خرائطها، أرقامها، خسائرها. لم يعد غياب الحرب يثير الانتباه. فالدفاع عن السلام لا يملك جاذبية استعراضية، ولا مردودًا رمزيًّا. لا توجد صور قوية تُعرض، ولا "سردية" قابلة للتسويق. بطبيعتها، تنأى السلام عن منطق اللحظة الذي يحكم المشهد الإعلامي المعاصر. لقد غدا السلام غير مرئي، ضحية لزمنه الطويل وطبيعته التراكمية.
ثانيًا: السلام المُؤدلج: بين المحاكاة والنفاق الدبلوماسي
رغم هذا التراجع، لا يختفي السلام تمامًا. فعندما يُطرح، يكون غالبًا مدفوعًا بحسابات استراتيجية أو أهداف نفعية. ففي عالم تغمره الحروب، تنتشر عمليات السلام التي في كثير من الأحيان تساهم في تجميد النزاعات بدلاً من إنهائها. وبذلك، تُستخدم هذه الآليات لإضفاء شرعية شكليّة على الاحتلال أو الهيمنة أو الوضع القائم الذي يصب في مصلحة الطرف الأقوى.
في حالات كثيرة — فلسطين، السودان، سوريا، أوكرانيا — يتم تحوير مفهوم السلام، ليُوظف في خدمة دبلوماسية زائفة. تصبح "اتفاقيات السلام" أدوات لإدامة النزاع بوسائل أخرى، فتُضفي شرعية على أوضاع غير عادلة تحت شعار الاستقرار. هذا الانحراف الدلالي يكشف هيمنة الواقعية السياسية على المثل السلمية: لم يعد السلام قيمة أخلاقية مطلقة، بل أداة تخدم مصالح جيوسياسية.
يَتجلّى هذا الاستخدام بشكلٍ واضح في أعطاب النظام الأممي، حيث يظل السلام أسيرًا لتوازنات مجلس الأمن. فتصميم المجلس الذي يعود لما بعد عام 1945 لم يعد يتناسب مع واقع العالم الحالي. إذ يعجز عن منع العنف أو وقفه، ويشكو من شلل ناجم عن الفيتوهات المتبادلة بين القوى الكبرى، مما يمنعه من التعبير بلغة عالمية تُجسد السلام.
تزداد حدة هذه الأزمة المؤسسية مع تشرذم الأيديولوجيات، حيث لم يعد السلام طموحًا مشتركًا يُجمع عليه الجميع، بل أصبح مطلبًا انتقائيًا متنازعًا عليه، بل وأحيانًا يحمل أبعادًا طائفية. فكل طرف يدافع عن تعريفه الخاص للسلام، مستبعدًا بذلك الآخرين من الحق في هذا المفهوم. ومن ثم، نجد أن "السلام الأمريكي" يتعارض مع "السلام الروسي"، كما أن "السلام الإسرائيلي" يتنافى مع "السلام الفلسطيني"، في سباق خطابي يفرغ مصطلح السلام من جوهره الإنساني والعالمي.
ثالثًا: الفلسفة والسوسيولوجيا في خدمة إعادة بناء مفهوم السلام
هل يعني هذا المأزق المفهومي أننا يجب أن نتخلى عن التفكير في السلام؟ تؤكد مسارات الفكر السياسي العكس. فمنذ إيمانويل كانط، الذي جعل من السلام أساسًا لقانون دولي جمهوري في كتابه "مشروع السلام الدائم" (1795)، وحتى أعمال يوهان غالتونغ (Johan Galtung) حول "السلام الإيجابي"، سعى المفكرون إلى منح السلام مضمونًا فعليًّا ومركبًا.
تُعلّمنا هذه التقاليد الفكرية أن السلام ليس غياب الحرب فحسب (سلام سلبي)، بل هو نظام علاقات عادل، منصف، ومستدام. سلام يُبنى، لا يُفرض. هذا التمييز الجوهري يسمح بتجاوز الثنائية العقيمة بين المثالية الساذجة والواقعية العدوانية، مقترحًا طريقًا ثالثة: سلمية بنّاءة، قادرة على تحويل البُنى المولّدة للعنف.
تبرز أهمية هذا المسار في السوسيولوجيا المعاصرة، حيث تكشف الدراسات أن شروط السلام ترتكز على عوامل اجتماعية قبل أن تكون عسكرية. فوفقًا للتحليل البنيوي، تغذي حالات اللاعدالة، والإذلال، والتمييز، والحرمان الثقافي، دوامات متجددة من العنف. وكما أوضح بيار بورديو(Pierre Bourdieu) ، تشكل علاقات الهيمنة الرمزية والعنف الخفي في الحياة اليومية — التي تفرزها البنى الاجتماعية والعادات والتراتبيات — أرضًا خصبة لنشوء النزاعات.
تكشف هذه القراءة البورديوزية حدود الحلول الدبلوماسية التقليدية. فالسلام لا يُختزل في توقيع بروتوكولي، بل يُنظم ضمن نسيج العلاقات الاجتماعية وتوزيع رؤوس المال الاقتصادية والثقافية والرمزية. وهو يتطلب تغييرًا في موازين القوى، يتجاوز الإطار الدولتي الكلاسيكي.
ولكي نفهم عمق التحديات التي تواجه السلام، لا بدّ من النظر إلى الديناميكيات الاجتماعية التي تحكم العلاقات الإنسانية. ففي هذا السياق، يسلط نوربرت إلياس (Norbert Elias)الضوء على مفهوم "عملية التمدن"، الذي يصف تهذيبًا تدريجيًّا للعلاقات الإنسانية عبر ضبط الذات وتشكيل فضاء سياسي مشترك. غير أن القرن العشرين أظهر أن هذه التهدئة لا تصمد دون اعتراف متبادل وجبر رمزي. فالإبادات وجرائم الإنسانيّة والصدمات الجماعية تُخلّف جراحًا ذاكرية تسمم العلاقات بين الشعوب. إن السلام الحقيقي يقتضي عملًا ذاكراتيًّا، وعدالة اجتماعية، وإعادة بناء للخيال الجمعي ويتطلب تفكيك الصور الذهنية السائدة، التي تُبقي على هرمية المنتصر والمهزوم، القوي والتابع.
رابعًا: نحو لغة سلام جذريّة: تحرير المخيال السياسي من الهيمنة
تدفعنا هذه الضرورة إلى قلب التجديد المفهومي المنشود. لقد آن الأوان لإعادة الاعتبار لكلمة "السلام"، لا كشعار إنشائي، بل كمشروع جذري لتغيير المجتمع. وهذا يتطلب قطيعة معرفية مع الأطر الفكرية الموروثة عن الحداثة الغربية وادعاءاتها الكونية.
فالسلام ليس استسلامًا، بل انتصار على قوى التدمير والتشييء. وهو ليس نسيانًا للظلم، بل تأسيسٌ لأشكال جديدة من التعايش تقوم على الاعتراف المتبادل والعدالة الجبرية. وليس حيادًا، بل إرادة قاطعة لفك الارتباط مع منطق الهيمنة الذي يحكم العالم اليوم.
هذا التحول الجذري يجد جذوره في هوامش الفكر الغربي. فحركات اجتماعية ومفكرون من الجنوب وتقاليد غير غربية يطرحون اليوم تصورات بديلة للسلام: جماعاتية، شمولية. وفي امتداد فكر فرانتز فانون (Franz Fanon) — الذي يُحتفى هذا العام بمئويته —، والذي رأى في العنف الاستعماري عقبة بنيوية أمام أي سلام حقيقي، تؤكد المقاربات المضادة للاستعمار ضرورة تحرير المخيال السياسي من إرث الإمبراطوريات لبناء سلام عادل قائم على الاعتراف بالاختلاف.
وتتردد أصداء هذه الرؤية في أعمال بوافنتورا دو سوزا سانتوس (Boaventura de Sousa Santos) ، الذي يدعو إلى "إبستيمولوجيا الجنوب"، قادرة على دمج معارف متنوعة وأنماط عدالة مستمدة من التقاليد الشعبية والأصلية، بعيدًا عن الأطر الأوروبية المهيمنة. يسمح هذا المنظور المنزاح بإعادة اكتشاف رؤى للسلام تتجاوز الثنائية الغربية بين الحرب والسلام، وتطرح نماذج شاملة للانسجام الاجتماعي.
تقترح الحركات والفلسفات الجماعية الإفريقية (أوبونتو Ubuntu )، والأمريكية الأصلية (بوين فيفير Buen Vivir)، تصورًا شاملًا لا يفصل السلام عن العلاقة المتوازنة مع الطبيعة والمجتمع والمقدس. هذه التقاليد الضاربة في القدم، التي طالما همّشها التفكير الغربي، توفر موارد مفهومية ثمينة لإعادة تأسيس النظام العالمي .إنها الأصوات التي يجب أن تُسمع، واللغات التي يجب أن تُترجم إلى الفضاء العمومي الكوني. إعادة فتح المخيال السياسي للسلام يعني استعادة أفقٍ للمستقبل قائم على التنوع والعدالة الفعلية والاعتراف المتبادل. كما يعني استئنافًا لتقليد إنساني يضع كرامة الإنسان في قلب الفعل السياسي.
السلام: المعركة السياسية الكبرى في عصرنا الحاضر
ليس غياب خطاب السلام دليلاً على عقم فكرته، بل على تصادمه مع السرديات المهيمنة التي تمجد القوة. خطاب السلام يُربك ويُزعج، ويطرح بدائل للعيش والوجود في هذا العالم، مما يدفع النظام الحالي إلى محاولات إسكات هذا الخطاب أو تشويهه لإبعاد طابعه التحرري.لكن، في زمن تواجه فيه البشرية تهديدات وجودية — من انهيارات بيئية وتوترات اجتماعية عالمية وديمقراطيات هشّة وانتشار نووي — لم يعد السلام ترفًا مثاليًا، بل ضرورة وجودية. البديل واضح: السلام أو الهمجية.
هذه الضرورة التاريخية تتطلب شجاعة سياسية نادرة وإرادة حقيقية للتغيير. من يجرؤ اليوم، في العواصم وأروقة المجالس وقاعات الجامعات ومنابر الإعلام، على النطق بكلمة "سلام" بصدق لا يتزعزع؟ من يملك القدرة على نطقها دون خوف أو تردد، كمن يضيء شمعة في الظلام؟ إن التلفظ بكلمة "سلام" في السياق الراهن يتجاوز مجرد الكلام ليصبح فعل مقاومة حقيقية، تحدياً لمنطق الحروب المهيمن، ورهاناً على إنسانية لا تستسلم، وعلى مستقبل يستحق أن نناضل من أجله.
بقلم أمين بن خالد، محامٍ ودبلوماسي سابق