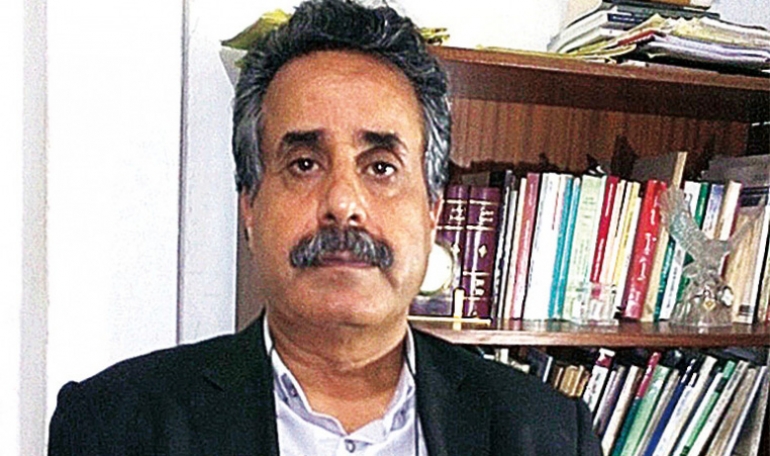حق الاستبدال والعزل» مفهوم الحكم الرشيد حسب وثائق الأمم المتحدة .
سبق أن تناولت في «المغرب» الأسس الفلسفية لحق الناخب في إعفاء أوعزل من انتخب،و أشرت إلى تناول الأسس القانونية لهذا العزل لاحقا ،و هو موضوع وجهة النظر التي تتناول المعنى القانوني للانتخاب ونظرية التفويض القانوني
I. المعنى القانوني للإنتخابات:
لم يضبط قانون الانتخابات المدلول القانوني «لفعل الانتخاب» من ذلك أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لم يعرف قانونا « الانتخابات » بل اكتفى بوصفها في الفصل 2 ( عاما حرا مباشرا ) وعرف الفصل 3 منه المقصود بالمفاهيم والأفعال المتصلة « بالفعل الانتخابي» (القائمة / الحملة / الحياد/ الصمت الانتخابي ...) دون ادني إشارة إلى ما هو المقصود قانونا « بالفعل الانتخابي « وخاصة ما هي الآثار القانونية التي تنجم عن اختبار ناخب معين لشخص آو أشخاص معينين وما هي طبيعة العلاقة القانونية التي تنشا بينهما بعد عملية التصويت .
فغياب ضبط آو تحديد للمعنى القانوني والآثار القانونية للعملية الانتخابية بين الناخب والمنتخب هو تقريبا السمة الغالية للقانون المقارن الذي اكتفى بتعداد شروط الانتخاب دون تفصيل للمعنى القانوني والطبيعة القانونية للفعل الانتخابي والعلاقة القانونية التي تنشا بين من قام بالانتخاب ومن وقع انتخابهélu /électeur وقد وردت إشارة عامة في الميثاق الاروبي للجماعات المحلية الذي أكد على إن «En élisant un maire , les électeurs délèguent à celui ci leur pouvoir d’action et plus généralement lui donner un mandat pour représenter la collectivité en son entier».
إذا فبهذا المعنى يكون الانتخاب هو» تصرف قانوني acte juridique « يقع بمقتضاه تفويض الناخب للمنتخب ببعض السلطات و تمكينه من وكالة للنيابة عنه.
فالانتخابات هي تكليف و توكيل أي أن بعد العملية الانتخابية تنشأ علاقة قانونية بين الناخب و المنتخب هي نفسها العلاقة القانونية بين الوكيل و الموكل في القانون المدني .
II. نظرية الوكالة القانونية
قد أجمعت تقريبا كل الدساتير على استعمال مصلح « الوكالة « لكنها اختلفت في ضبط طبيعة هذه الوكالة ( أى الوكالة بين الناخب /المنتخب) فبعض القوانين الدستورية كانت صريحة في اعتبار إن العلاقة بين الناخب و المنتخب هي علاقة وكالة ولكنها من صنف خاص أي أنها وكالة غير ملزمة بين الوكيل والموكل والمنتخب ) غير ملزم بان يخضع لتعليمات وشروط و رقابة و توجيهات موكله (ناخبه) حيث نص صراحة الفصل 27 من الدستور الفرنسي على أن « الوكالة الملزمة باطلة» و أكد على ذلك كذلك دستور ليبيا 2016 في الفصل 95 على أن عضو المجلس الدستوري يمثل «الشعب كله و لا يجوز تحديد وكالته بقيد آو شرط « كما نص الفصل 50 من الدستور الموريتاني على أن « كل انتداب إلزامي باطل».
كما ذهب في نفس الاتجاه مثلا الدستور الجزائري بالفصل 10 حيث أكد انه «لا حدود لتمثيل الشعب» .
فالدساتير التي اختارت قاعدة الوكالة غير الملزمة أو التي اعتبرت أن الوكالة الملزمة باطلة«le mandat impératif est nul » هي دساتير أرادت أن تجعل من المنتخب و الناخب في علاقة وكالة و لكن دون احترام النظام القانوني لعقد الوكالة أي انه بالعملية الانتخابي يقع توكيل المنتخب و لكن من حقه أن لا يحترم الآثار القانونية لعقد الوكالة ومنها واجب احترام إرادة الموكل و احترام موضوع الوكالة وحدودها وكذلك تمكين الموكل من حق عزل الوكيل . وقد لخص هذه الوضعية احد الدارسين حين قال « ... أصبح عضو البرلمان يمثل الآمة بأسرها مما جعله حرا في إبداء راية دون التقيد بالتعليمات الإلزامية للناخبين ... وأصبح غير مسئول مدنيا عن نيابته إمامهم ...».
فحسب نظرية بعض الدساتير فإن المنتخب وكيل في الامتيازات (تمثيل الناخب /اتخاذ القرارات....) ولكن بدون أن يكون له التزامات خاصة تجاه الناخب ودون أن تكون للناخب الحق في إنهاء عقد الوكالة / التفويض متى اعتبر أن الوكيل /المنتخب لم يحترم شروط الوكالة وحدودها و أهدافها لأنه من البداية غير ملتزم أمام من انتخبه وان « وكالته لم ترتبط بقيد آو شرط من قبل من انتخبه « ( الفصل 27 من الدستور اللبناني) .
أما بعض الدساتير الأخرى ومنها دستور تونس 2014 فقد اختارت السكوت ولم تشر في أي بند من بنودها إلى مسألة الوكالة و لم ترفض صراحة فكرة الوكالة الملزمة فما يمكن أن يؤول على أن دستور 2014 لا يعارض مبدأ «الوكالة الملزمة» خاصة أن هذا الموقف الضمني يتعزز بملاحظة أن دستور 2014 لم يشر إلى مبدإ سيادة الأمة ومبدإ أن الناخب هو «نائب الأمة جمعاء» (كما جاء دستور 1959) وهي حسب الدراسات و البحوث القانونية المكونات الرئيسية التي تخلق نظاما قانونيا خاصا من أهم ملامحه رفض آو قبول مبدأ الاستفتاء ألعزلي لأنه وباعتبار « أن عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها ... فانه يراعي الصالح العام للأمة وليس مصلحة ناخبيه ... ولا يجوز للناخبين عزله متى شاءوا أثناء عضويته» .
فالدساتير التي ترفض الوكالة الملزمة و تقر بسيادة الأمة عوضا عن سيادة الشعب و تعتبر أن النائب هو نائب الأمة و ليس نائب من انتخبه هي دساتير لا تقبل مبدأ العزل من حيث المبدإ ، وإما الدساتير التي تذهب في الاتجاه المعاكس (سيادة الشعب/ غياب مبدأ نائب الأمة/ غياب رفض صريح للوكالة الملزمة) هي دساتير تقر صراحة أو ضمنيا الحق في العزل وتكريس فكره أن هذه الوكالة الناجمة عن الانتخابات هي وكالة عادية خاضعة للقواعد الأساسية للقانون المدني. (1) وهذه الدساتير « تعطي للناخب الحق في عزل النائب بعد جمع عدد معين من التواقيع ...».
هذه الدساتير تعتبر أن العملية الانتخابية وبعد عرض البرنامج الانتخابي من قبل المرشح / المنتخب يقع تكليفه بتوكيل من قبل الناخب توكيلا مدنيا والذي يكون بمقتضاه الوكيل /المنتخب «ملزم أن يتمم ما وكل عليه من دون زيادة أو نقصان وليس له أن يتجاوز حدود وكالته و لا أن بفعل شيئا خارجا عن توكيله» (الفصل 1121 المجلة المدنية التونسية) و أن هذه الوكالة تنتهي بعدة أسباب منها «عزل الوكيل» حسب الحالة 3 من الفصل 1157 منن نفس المجلة (2).
فإذا اعتبرنا أن الفعل الانتخابي يفرز عقد وكالة عادية بين الناخب و المنتخب فإن هذا العقد/الاتفاق يخضع للنظام القانوني لعقد الوكالة و أن هذا العقد يتناهي متى شاء (حسب عبر ة الفصل 1160 على المدنية ) صاحب سلطة قرار إسناد الوكالة ( الموكل / الناخب ) لان الذي له سلطة تفويض هذه السلطة (و لا تخلي عنها) يحق له في نفس الاتجاه إيقاف مفعول هذا التفويض و» عزل الوكيل... و أي شرط ينافيه لا عمل عليه « ( الفصل 1160 المجلة المدنية).وهو الاتجاه الواضح في القانون المدني التونسي ولا يوجد ما يعارضه في دستور 2014 .
ما يمكن ملاحظته في ختامة هذا الجزء و أن بعض الدراسات و في إطار سعيها لتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الناخب و المنتخب قد ذهبت إلى اعتبار أن المنتخب ليس ممثلا للناخب بل هو مجرد عون agent بل أكثر من ذلك هو serviteur (بالمعنى القانوني و ليس بالمعنى الديماغوجي ) و هي النظرية التي يدافع عليها بعض الدارسين الأمريكيين اليوم وإسنادا إلى جون جاك روسو .(3)
• ملاحظات ختامية:
أن غياب إقرار حق العزل كقاعدة قانونية عامة وكجزء من التشريع الذي ينظم الحياة السياسية ( حق الانتخاب يقابله حق المراقبة وحق العزل ) في التشريع التونسي هو الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى حالات من الاستبداد والمأزق وتعارض بين الواقع الموجود والواقع المنشود وبين الشرعية الانتخابية والمشروعية الشعبية ويؤدي إلى :
ـ إما تحركات شعبية وعامة ( كثير من الأحيان بمنسوب معين في العنف ) لإنهاء المنظومة القائمة وان كانت منتخبة فإنها صارت بدون مشروعية .
ـ تحرك إحدى أجهزة الدولة المنضمة كالجيش ( حالة مصر والسودان ) أو الوزير الأول (حالة بن علي وحركة 7 نوفمبر ) أو رئاسة الجمهورية كما هو الحال في تونس منذ يوم 25 جويلية 2021 . إستنادا للقانون الدستوري أو القانون الانتخابي لإيقاف هذا التعارض بين الشرعية والمشروعية وإنهاء صورة «الديمقراطية المتعارضة مع الديمقراطية» (Démocratie contre la démocratie) أي بين ديمقراطية شكلية أفرزتها الانتخابات ( النزيهة شكليا ) وبين واقع عامة الناس ومزاجهم الجماعي وعادة ما يكون ذلك في إطار تجاذبات وتفسيرات غير متجانسة للدستور والقانون ( كما هو الحال للفصل 80 من الدستور).
إذا فإحدى أوجه شروط الاستقرار السياسي والديمقراطية الحقيقة هو إقرار تشريعي صريح (في الدستور كمبدإ في القانون الانتخابي كإجراءات عملية ) لحق الناخب / الشعب وباستعمال آلية الاستفتاء العزلي لإنهاء عهدة من وقع تكليفه بذلك سواءا على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني وحتى يقع تفادي وتجنب في كل مرة هذا التضاد بين شرعية فقدت مشروعيتها وبين مشروعية تبحث عن شرعيتها وتكون عمليات الإصلاح والتصحيح كلها بالية واضحة وهي أليه الاستفتاء العزلي القانوني بعيد عن الجدل القانوني المرهق .
-----------------
1) « ... في ضل الديمقراطية النيابية يقوم الشعب على انتخاب النواب يباشرون السلطة نيابة عنه ولا يقوم الشعب بالاشتراك مع النواب في ممارسة السلطة إذ يترك ذلك للنواب وحدهم ويقف دور الشعب عند حد انتخاب ممثليه الذين يستقلون تماما بعد هذه الانتخابات بمباشرة السلطة التشريعية» (خالد عبد الرحمان/ المرجع السابق ص 36)
2) بعض الدراسات ذهبت إلى اعتبار إن المنتخب هو أجير تربطه بناخبه نوع خاص من عقود الشغل إما الدستور الموريتاني فقد استعمل عبارة « انتداب « ( الفصل 50 )
3) … « الحاكم هو مجرد موظف أو مفوض أو نائب أو موكل عن الأمة » /حسن داري المرجع السابق
« … un élu est un agent ou un serviteur (mandataire et non un maitre ou un décideur autonome « (fonde de pouvoir ) ( Aperçu sur le referendum révocatoire aux U.S.A p.41)
الأساس القانوني لحق الناخب في إعفاء أوعزل من انتخب
- بقلم المغرب
- 10:21 27/08/2021
- 1356 عدد المشاهدات
بقلم: الأستاذ سالم السحيمي المحامي لدى التعقيب
«أن الحكم الرشيد يرتكز على ثلاثة أعمدة وهي : حق الاختيار / حق الرصد والتتبع والمراقبة /