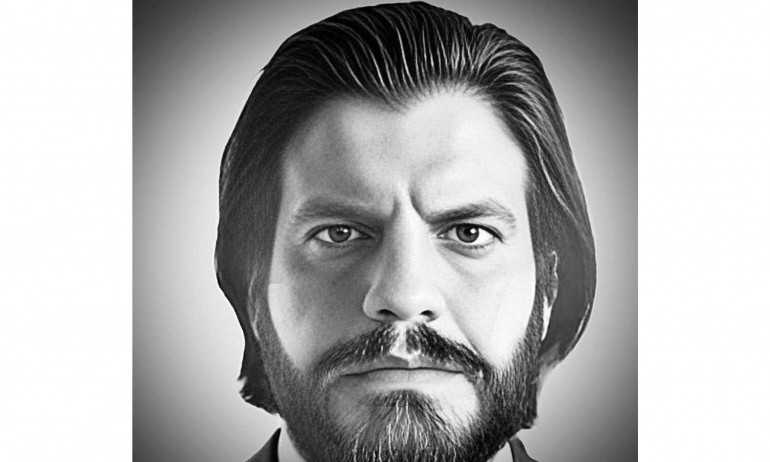مؤلفه البارز "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، متأثراً بفلسفة هيغل (Hegel) وأفكار ألكسندر كوجيف . (Alexandre Kojève) طرح فوكوياما رؤية جريئة مفادها أن البشرية تتجه حتماً نحو نموذج سياسي واحد وشامل: الديمقراطية الليبرالية مقرونة باقتصاد السوق الحر. وقد بدا انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة تأكيداً لهذا الطرح، حيث انتصر النموذج الغربي وأصبح حقيقة تاريخية لا جدال فيها.
رأى فوكوياما في هذا التطور تجسيداً لمفهوم "الصراع من أجل الاعتراف" عند هيغل ، حيث سيحقق الإنسان أخيراً — بصفته ذاتاً معترفاً بحقوقها — السكينة والاستقرار في ظل النظام الليبرالي المعولم. غير أن هذه الرؤية الحالمة لم تصمد طويلاً أمام اختبارات الزمن. فبدلاً من التوحد المنشود، تشظى العالم إلى نزاعات مستعصية وأزمات قومية وبنيوية. وعوضاً عن أن يصل التاريخ إلى نهايته، انفتح من جديد بضراوة لم يتوقعها أحد.
عودة الفوضى إلى المسرح العالمي
مع بزوغ القرن الحادي والعشرين، انزلق الكوكب نحو حقبة جديدة من عدم اليقين المطلق. وهكذا فتحت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 عهداً جديداً، حلّت فيه الحروب غير المتكافئة محل الصراعات الأيديولوجية الكلاسيكية. فالتدخلات العسكرية في العراق (2003) وأفغانستان أطاحت بالاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتوالت الصدمات: الحروب الأهلية الطاحنة في سوريا واليمن، تجدد التوترات في القوقاز، والانفجار الليبي منذ 2011، كلها تحولت إلى بؤر عنف مزمنة.
وقد أعاد النزاع الأوكراني، الذي اندلع عام 2014 وتفجر مجدداً في 2022، شبح الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا. وسط هذا المشهد الكارثي، تبقى غزة، بألمها المستدام، رمزاً لمأساة تُعاد بلا نهاية: دائرة من الدم والدمار، حيث يتحول الماضي إلى نسخة قاتمة من الحاضر، والحاضر إلى وعد بمأساة مقبلة.
وإلى جانب النزاعات التقليدية، يطفو على السطح طيف جديد من المخاطر الحديثة: الأوبئة العابرة للقارات، الجرائم السيبرانية، الثورة التكنولوجية عبر الذكاء الاصطناعي، والتقلبات المناخية والكوارث الطبيعية. وهكذا، بدلاً من السلام الموعود، يبدو العالم محاصراً في دورة لا تنتهي من الأزمات المتشابكة والمتلاحقة.
من تراكم التاريخ إلى تبدد الذاكرة
بحسب الرؤية الهيغلية، يُنظر إلى التاريخ كمسار تراكم مستمر ومنظم: تتعلم الشعوب والحضارات من كوارثها، تهضم تناقضاتها، وترتقي تدريجياً نحو أشكال أرقى من العقلانية الجماعية. إلا أن عصرنا الراهن يشهد قطيعة واضحة: لم تعد ذاكرة الصراعات والمآسي تتحول إلى تعلم حضاري مشترك.
فدروس القرن العشرين تتضاءل وتتلاشى بصورة مقلقة. الحربان العالميتان فقدتا قدرتهما على التحفيز والتنبيه، وتجربة الاستعمار بعنفها البنيوي تميل إلى التهميش أو الإنكار التام. أما هيروشيما وتشرنوبيل، فبدلاً من أن تغذيا وعياً بيئياً وكونياً، تبدوان ملفات أرشيفية صامتة. كأن الذاكرة الجماعية فقدت وظيفتها الأساسية عبر الأجيال.
وكما كتب بول ريكور (Paul Ricœur)، "الذاكرة ليست مجرد استحضار، بل مسؤولية أخلاقية تجاه الماضي". واليوم، تتعرض هذه المسؤولية للتآكل أو التوظيف الضيق، فتغدو التجربة التاريخية شذرات مبعثرة تحت ثقل التدفقات الرقمية وصراعات السرديات، وقد فقدت قدرتها على إنتاج وعي جماعي.
النسيان كقوة محركة للراهن
لا يعني الحديث عن "نهاية الذاكرة" فراغاً، بل فيضاً خانقاً: صور تتكاثر بلا توقف حتى ينصهر الألم في تكرار رتيب، فلا يترك أثراً ولا ذاكرة، ويتحول الأرشيف إلى أرخبيل من شظايا رقمية، ويغدو الحدث لحظة عابرة تتبخر في زحمة الزمن.
في هذا السياق، نجد أن الحروب في السودان أو أفريقيا الوسطى، والنزوح الجماعي عبر المتوسط، كلها لا تولد وعياً مستداماً، بل تندرج ضمن سلسلة من "الطوارئ الإعلامية" سريعة الزوال. وهذا النسيان العام يفتح الطريق أمام إعادة إنتاج الأخطاء عينها بعماء مطلق.
وتستأنف الحرب في غزة كلحن مأساوي لا ينتهي، والبلقان التي شهدت تفككاً دموياً في التسعينات ما تزال تعيش على وقع توترات دفينة. إقليم ناغورنو كاراباخ، مسرح نزاعات متقطعة منذ 1988، يجسد استمرار جروح لم تندمل قط. في هذه السياقات، لا يخدم الماضي الوقاية من تكرار الأخطاء، بل يغذي نيران الصراع. لم يعد التاريخ رصيداً للتجارب المفيدة، بل خزاناً للاستغلال السياسي.
الجائحة والذكاء الاصطناعي والمناخ: المخاطر الغائبة عن البصيرة
قدمت جائحة كوفيد-19 درساً قاسياً: عالم يختنق بوفرة الاتصالات لكنه يفتقر إلى وحدة القرار. وبدلاً من أن تترسخ كذاكرة جمعية عن هشاشتنا المشتركة، تحولت إلى نزاع سياسي وجدال عقيم حول اللقاحات، لتترك وراءها فراغاً معرفياً وأفقاً أكثر خطراً.
كما أن الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة أنثروبولوجية وأخلاقية جوهرية، لكن في غياب ذاكرة تاريخية راسخة، تكرر المجتمعات الأخطاء نفسها: الانبهار التقني الأعمى، وغياب الضوابط، والعمى عن العواقب الاجتماعية. والقضية المناخية تتبع نفس المسار: رغم الحرائق الهائلة والفيضانات وموجات الجفاف، تبدو البشرية عاجزة عن تحويل التجارب إلى ذاكرة سياسية فعالة.
عصر الحاضر المطلق
نعيش اليوم ما يسميه المؤرخ الفرنسي فرانسوا هارتوغ" (François Hartog) نظام الزمنية الحاضرية": زمن مسحوق تحت وطأة الإلحاح، حيث لا الماضي ولا المستقبل يوجهان الفعل الإنساني. وهذا المنطق يولد خسارتين متزامنتين: ضياع الذاكرة وفقدان البصيرة المستقبلية. فبلا ذاكرة، تعيد البشرية ارتكاب زلاتها الكارثية؛ وبلا تصور للمستقبل، تحكم على نفسها بردود فعل مرتجلة ومذعورة.
في هذا الإطار، تنهار أسس الديمقراطية الليبرالية — التي رأى فوكوياما فيها مصير البشرية المحتوم — بفعل فقدان جذورها التاريخية. دولة القانون، والتضامن الاجتماعي، والنظام الدولي الناتج عن الحروب العالمية، كل هذا يتآكل تدريجياً. وبدون ذاكرة حية، تختزل الديمقراطية في إدارة باردة وتقنية، معرضة لصعود الشعبوية والاستبداد.
من أجل استعادة الذاكرة كفعل سياسي
أمام "نهاية الذاكرة"، لا يقتصر الأمر على استعادة ماضٍ مضى، بل يتطلب ابتكار ذاكرة حية وفاعلة. يذكّرنا موريس هالبواكس (Maurice Halbwachs) بأن الذاكرة بطبيعتها جماعية، تُبنى في قلب التفاعل الاجتماعي، وأن التجارب الإنسانية لا تُحفظ بمعزل عن روابطها مع الآخرين. ومن هنا، يصبح ابتكار سياسة ذاكرة حيّة أمراً أساسياً لربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وضمان أن تتحول التجارب إلى وعي جماعي قادر على توجيه الفعل البشري. وهذا يستلزم:
أولاً، إعادة الاعتبار لتعليم التاريخ، ليس كحفظ للتواريخ والأرقام، وإنما كوعي بالمحن الكبرى التي واجهتها الإنسانية عبر مسيرتها.
ثانياً، التعامل مع الأزمات الكوكبية — المناخ، الذكاء الاصطناعي، الأوبئة — كإرث مشترك يتطلب استجابات ذاكراتية وليس حلولاً تقنية فقط.
ثالثاً، تثمين ذاكرة الضحايا والشعوب المستعمرة والأقليات المضطهدة، لمنع أن يفضي محو تجاربها إلى عنف جديد.
لقد كانت "نهاية التاريخ" التي أعلنها فوكوياما مجرد وهم، أما "نهاية الذاكرة" فتمثل تهديداً حقيقياً: عالم محكوم عليه بتكرار المآسي نفسها بلا قدرة على استخلاص الدروس.
أي ذاكرة للمستقبل؟
تقف الإنسانية اليوم على مفترق طرق حاسم: إما أن تستسلم لهذا النسيان الكوكبي، حيث تتكرر الصراعات في حلقات مفرغة ويكتشف كل جيل أهوال التاريخ بلا رصيد من التجربة، أو أن تبتدع سياسة ذاكرة جديدة، قادرة على ربط الماضي بالحاضر والمستقبل في نسيج واحد. إن هذه السياسة ليست مجرد إعادة سرد للتواريخ، بل هي مشروع حضاري وفلسفي وأخلاقي، يربط بين التجربة الإنسانية الفردية والجماعية، ويعيد للذاكرة مكانتها كمرشد للفعل وصانع للوعي.
إن المهمة الحقيقية للقرن الحادي والعشرين ليست إنهاء التاريخ كما توهم فوكوياما، وإنما إنقاذ الذاكرة من الضياع والتبدد. فبدون ذاكرة حية، لا يمكن للإنسانية أن تتعلم من ماضيها أو تبني مستقبلاً أفضل. بل تتحول الأحداث إلى دوائر مفرغة من العنف، ويغدو الحاضر مشوشاً بلا جذور، والمستقبل مرهوناً بالارتجالات والتهور.
إن بناء ذاكرة فاعلة يعني تحمل المسؤولية المشتركة عن تجارب البشرية، حماية ما تبقى من وعي جماعي، واستثمار الدروس المستخلصة من المآسي والصراعات السابقة كأدوات لإرساء العدالة، التضامن، واستدامة الحياة على كوكبنا. وفي ظل الحروب الراهنة، من أوكرانيا إلى غزة ، التي تبدو بلا مخرج واضح، يزداد الضغط على الإنسانية لاستعادة وعيها التاريخي، لتجنب تكرار مآسيها.
فإرادة الذاكرة هي إرادة إنسانية بامتياز، وهي الشرط الأساسي لكي تصبح الإنسانية قادرة على مواجهة تحدياتها الكبرى، من الأوبئة والمناخ إلى الثورة التكنولوجية، دون أن تقع في فخّ النسيان المتكرر، الذي يعيد إنتاج المعاناة نفسها بلا نهاية.
بقلم:أمين بن خالد