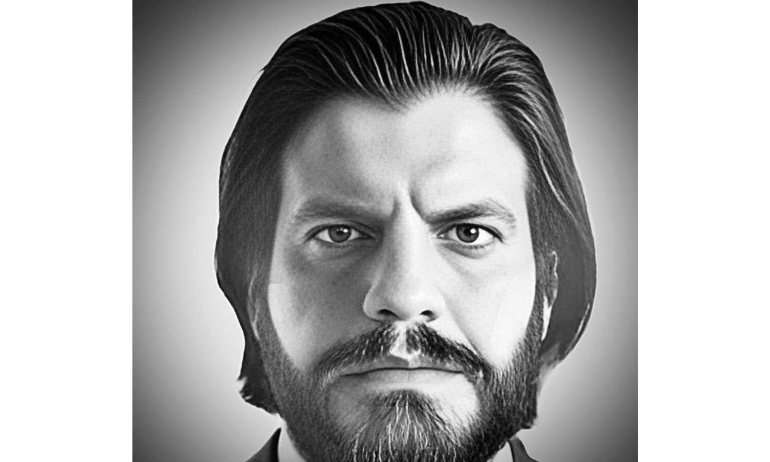منذ أرسطو، ارتكز الفكر الغربي على فئات جوهرية – الزمن، المكان، الجوهر، العلاقة، الملكية – لترتيب العالم وتنظيمه. وقد شكلت هذه الأُطر، التي رافقت الفلاسفة والقانونيين والدبلوماسيين عبر قرون، رؤية مستقرة وهرمية للكون. غير أن القرن الحادي والعشرين قلب هذا النظام رأسًا على عقب، مدشناً عصراً جديداً من التعقيد الجيوسياسي.
فبينما كانت العلاقات الدولية تُفهم بوضوح من خلال هذه الشبكات التقليدية، نجدها اليوم تتهرب من كل تبسيط أو تصنيف صارم. ولعل هذا التحول الجذري يطرح علينا تحدياً إبستمولوجياً حقيقياً، وهو ضرورة التفكير في التعقيد ذاته كمنطق حاكم للعالم المعاصر.
في هذا السياق، يذكرنا عالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران في مؤلفه الرائد «المنهج» (1977) بأن "التعقيد ليس عقبة تُتجاوز، بل تحدٍ يتطلب المواجهة والإدراك العميق." ذلك أن التشابك العالمي، الممزوج بالتنافسات والصراعات، ينتج نظاماً تتعايش فيه الأنظمة في ديناميكية فوضوية متشابكة.
وهكذا، لم تعد أدوات الفكر التي ورثناها من أرسطو، والمصممة لعالم يمكن التنبؤ به، صالحة لفهم هذا الواقع الجديد. من هنا، بات من الضروري بناء قواعد جيوسياسية جديدة تمكننا من الإبحار في هذا الكون المتحرك والمتغير باستمرار.
الزمن المبعثر: تنوع الإيقاعات وتداخلها
إن المقاربة الأرسطية للزمن، التي تنظر إليه كسلسلة خطية قابلة للقياس، لم تعد تكفي في عالمنا المعاصر، حيث تتشابك أزمنة متعددة ومتباينة الإيقاعات. وقد سبق للمؤرخ الفرنسي فرناند بروديل، في عمله الموسوعي «الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية» (1979)، أن أوضح هذا التعدد الزمني بفصله الدقيق بين الزمن الطويل للحضارات والزمن القصير للأحداث.
بيد أن هذا التمييز الثنائي قد تشظى اليوم إلى أبعاد أكثر تعقيداً وتركيباً، يمكن تلخيصها في أربعة مستويات زمنية متداخلة:
أولاً، الزمن الطويل للقوى الناشئة، حيث تخطط بعض القوى صعودها على مدى عقود، بوضع استراتيجيات تمتد لأجيال كاملة، كما تفعل الصين عبر رؤيتها المعلنة لعام 2049.
ثانياً، الزمن المتوسط للمؤسسات الدولية، والذي يتجلى مثلاً في الأمم المتحدة التي تضع أهدافها للتنمية المستدامة ما بين 2015 و2030، فتعمل ضمن دورات عقدية.
ثالثاً، الزمن المسرّع للأسواق، حيث تُتخذ القرارات المالية بواسطة الخوارزميات خلال أجزاء من الثانية، منفصلة تماماً عن إيقاعات السياسة التقليدية.
وأخيراً، الزمن اللحظي لشبكات التواصل، حيث قد تشتعل أزمة وتتلاشى في غضون ساعات معدودة، مما يفرض على القادة ردود فعل عاجلة تأتي أحياناً على حساب التحليل العميق والمدروس.
في هذا الإطار، يشير عالم الاجتماع الألماني هارتموث روزا، في كتابه المرجعي «التسارع» (2010)، إلى أن «التسارع الاجتماعي» يشكل مصدر توتر دائم في العلاقات الدولية. وبالفعل، فإن هذا الاختلاف الجذري في إيقاعات الزمن بين الجهات الفاعلة يجعل من التنسيق بين الجداول الزمنية الاستراتيجية أمراً بالغ الصعوبة، ويعقّد المفاوضات الدولية إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال، تتطلب الأزمات المناخية استجابات طويلة الأمد وتخطيطاً استراتيجياً ممتداً، بينما تفرض الضغوط الإعلامية والرأي العام حلولاً سريعة وآنية.
المكان المتلاشي: حدود مرئية وأراضٍ غائبة
على نحو مماثل، لم يعد المكان – وهو ركن أساسي آخر من أركان الفلسفة الأرسطية – إطاراً ثابتاً وقاراً كما كان في الماضي. فرغم أن الحدود الجغرافية تبقى ظاهرة وملموسة على الخرائط، إلا أنها تتخللها تدفقات متنوعة – من هجرات بشرية، ورؤوس أموال، وبيانات رقمية، وحتى أوبئة – تجعلها مسامية وهشة الحواجز.
وقد وصف الأنثروبولوجي الفرنسي مارك أوجيه، في عمله النقدي "اللا أمكنة – مدخل إلى أنثروبولوجيا الحداثة فائقة السرعة" (1992)، هذه الأماكن العابرة للحدود – مثل المطارات، والمناطق الحرة، والمنصات الرقمية – بأنها أراض منفصلة عن المنطق الجغرافي التقليدي.
وإلى جانب هذا التسييل الجغرافي، نشهد ظاهرة لافتة تتمثل في قدرة الدول الصغيرة على التأثير بصورة تفوق حجمها الجغرافي. فدول مثل قطر، عبر دبلوماسيتها النشطة أو سيطرتها على موارد استراتيجية، تستطيع أن تثقل كفتها الاستراتيجية بشكل يتناقض مع مساحتها المحدودة.
ولكن الأهم من ذلك كله، أن الفضاء الجيوسياسي لم يعد يقتصر على الأراضي المادية فحسب، بل امتد ليشمل الفضاء السيبراني، والمدارات الفضائية، والكابلات البحرية التي تنقل حوالي 95% من البيانات العالمية. وكما يعبر عالم الاجتماع الفرنسي برونو لاتور بدقة: «لم نعد نعيش على نفس الخريطة». لقد تحول الفضاء الاستراتيجي إلى طبقات متراكمة من الأراضي الملموسة وغير الملموسة، حيث تعيد البنى التحتية الخفية تعريف مفهوم السلطة ذاته.
العلاقات المتناقضة: استراتيجيات في إدارة التناقض
من جهة أخرى، كانت الدبلوماسية الكلاسيكية تقسم العالم بوضوح إلى حلفاء وأعداء ومحايدين، في تصنيف ثلاثي واضح المعالم. غير أن هذه الوضوحية ذهبت أدراج الرياح في عالم اليوم المعقد.
فنجد اليوم دولاً، رغم عضويتها في تحالفات عسكرية محددة، تعقد اتفاقات استراتيجية مع منافسين جيوسياسيين. وأخرى تتعاون في ملفات معينة، في حين تحافظ على شراكات متنافسة في مجالات أخرى. هذا التناقض الظاهري ليس خللاً في النظام، بل هو جوهره الحقيقي.
يرى عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان، في كتابه الشهير «الحداثة السائلة» (2000)، أن هذه السيولة هي جوهر العصر الحديث: علاقات تتشكل وتتبدل باستمرار حسب السياقات والمصالح المتغيرة.
وبناء على ذلك، تفرض هذه السيولة دبلوماسية توازن دقيقة ومعقدة، حيث ينبغي للدول أن تبحر في شبكة من التحالفات غير المستقرة، تصبح فيها التناقضات هي القاعدة وليس الاستثناء. إن إدارة هذه التناقضات تتطلب مرونة استثنائية ورؤية استراتيجية عميقة، وتحول الدبلوماسية إلى فن حقيقي للإبحار في المجهول.
الملكية اللامادية: قوة التدفقات
أما مفهوم الملكية عند أرسطو، فكان يشير إلى شيء ملموس ومحدد، كقطعة أرض أو ممتلك مادي واضح المعالم. لكن في عالم اليوم، يكمن النفوذ الحقيقي في السيطرة على التدفقات – من الطاقة، والمال، والبيانات، وخصوصاً على الروايات الثقافية التي تشكل وعي الشعوب.
لقد أعادت خطوط الأنابيب، والكابلات البحرية، والأقمار الصناعية، والمنصات الرقمية مثل "إكس" (سابقاً تويتر) تعريف مفهوم السيادة بالكامل. وكما كتب الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في عمله «المراقبة والمعاقبة» (1975)، فإن السلطة لا تُمارَس عبر الملكية المادية وحدها، بل من خلال التحكم في التدفقات والمسارات الحيوية.
تعقد هذه التحولات الجذرية ممارسة السيادة التقليدية، إذ يمكن لدولة أن تفقد جزءاً من أراضيها ولكنها تعزز نفوذها عبر الشبكات الرقمية والاقتصادية. وبالمقابل، تنتقل النزاعات إلى هذه المجالات اللامادية، فتصبح الهجمات السيبرانية قادرة على شل اقتصادات كاملة، تماماً كما تفعل العمليات العسكرية التقليدية. وأصبحت معركة السيطرة على الخطابات في الشبكات الاجتماعية، حيث تنتشر المعلومات المضللة والحروب الناعمة، محوراً استراتيجياً حيوياً لا يقل أهمية عن التسلح التقليدي.
بين البينين: مملكة الغموض
وفي المحصلة، يمكن القول إن العالم المعاصر هو عالم «ما بين البين»؛ فهو لا يعيش حرباً عالمية ثالثة صريحة، ولا ينعم بسلام دائم ومستقر. بل هو فضاء معقد تتخلله حروب ونزاعات موضعية، وصراعات «تحت العتبة» مثل الهجمات السيبرانية، والحروب الاقتصادية، وعمليات التأثير الثقافي والإعلامي.
هذه الصراعات الخفية تترك آثاراً تقارب آثار الحروب المعلنة، وإن غابت عنها شرارة الإعلان الرسمي أو البروتوكولات التقليدية للنزاعات المسلحة. يصف إدغار موران، في «مقدمة في الفكر المعقد» (1990)، هذا الفضاء الملتبس بأنه «مملكة الغموض»، حيث ينسج النظام والفوضى معاً خيوط الواقع الجديد.
من ناحية أخرى، تكشف علوم النفس ونظريات الأنظمة المعقدة أن المؤسسات تبلغ ذروة ابتكارها أحياناً عند حافة الفوضى. وفي الجيوسياسة، يمكن أن يتحول هذا الاضطراب الخلاق إلى محرك حقيقي للتغيير والتطوير. فالأزمات الكبرى، سواء كانت مناخية أو مرتبطة بالهجرة أو بالأوبئة، تدفع الفاعلين الدوليين إلى إعادة صياغة استراتيجياتهم جذرياً، كما نراه في إدارة تدفقات المهاجرين أو البحث المحموم عن الاستقلالية في مجال الطاقة.
نحو إبستمولوجيا التعقيد
في مواجهة هذه التحولات العميقة والجذرية، يصبح التشبث بالأطر الأرسطية أشبه بمحاولة الإبحار بخريطة بائدة في بحر تغيّرت تضاريسه بالكامل. فالجيوسياسة في عصر التعقيد تفرض علينا وصل الأزمنة المتباينة، وتراكب الأمكنة المتعددة، والتعامل مع التناقضات بوصفها أوضاعاً مؤقتة قابلة للتحوّل والتبدل.
في هذا السياق، تقدّم فلسفة الفكر المعقد لإدغار موران، كما بلورها في مشروعه الفكري الضخم «المنهج»، رؤية منهجية متقدمة تقوم على التأطير العميق، وربط المعارف المتنوعة، والاعتراف الخلّاق بعدم اليقين، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الواقع لا يمكن إقصاؤه أو تجاهله.
وتدعو هذه المقاربة التجديدية إلى جيوسياسة عابرة للتخصصات، تستوعب التاريخ بامتداداته الطويلة، والاقتصاد بتشابكاته المعقدة، وعلم الاجتماع بعمق تفاعلاته، والبيئة كإطار حاكم لمستقبل البشرية جمعاء. ذلك أن الأحداث الجيوسياسية لا تنبع من سبب منفرد وبسيط، بل تتشكل من تداخلات معقدة وتفاعلات غير متوقعة، حيث تمتزج المصادفة بالضرورة، وتتقاطع القوى الظاهرة مع العوامل الكامنة في رسم ملامح العالم الجديد.
استشراف المستقبل: صياغة قواعد لعالم غير يقيني
يمكن القول إن القرن الحادي والعشرين قد أعاد رسم المسرح الدولي بالكامل، محطماً الأطر الأرسطية التقليدية ليفرض تعقيداً جديداً لا يمكن اختزاله في صيغ بسيطة. أزمنة متفتتة، وأماكن متراكبة، وعلاقات متدفقة، وملكية غير مادية: هكذا يبدو العالم اليوم كمحيط متحرك، حيث تحل البوصلات المتكيفة محل الخرائط الثابتة.
إن التفكير في الجيوسياسة اليوم يعني، بالضرورة، احتضان هذا اللايقين كفرصة حقيقية لإعادة ابتكار الذات والاستراتيجيات. وتدعو هذه القواعد اللغوية الجديدة إلى تجاوز الانقسامات الثنائية التقليدية – حليف أو عدو، نصر أو هزيمة – لبناء استراتيجيات مرنة ومتطورة، قادرة على توقع التفاعلات المعقدة واستيعابها.
كما تتطلب هذه المرحلة الجديدة حوكمة عالمية متجددة تعترف بتعدد الأزمنة والأمكنة، مع فهم عميق لدور التدفقات كمفاتيح جديدة للسلطة والنفوذ في القرن الحادي والعشرين.
وفي المستقبل المنظور، ستكون القوى التي تستطيع قراءة هذا العالم السائل والمتحرك – ليس كفوضى مهددة ومخيفة، بل كفضاء خصب للفرص والإمكانيات – هي التي ستشكل ديناميكيات الغد وتوجه مسار التاريخ.
ويبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل ستتمكن البشرية جماعياً من ابتكار الأدوات الفكرية والسياسية اللازمة لتبحر بنجاح في هذا الأفق الغامض والمفتوح على كل الاحتمالات؟
بقلم: أمين بن خالد