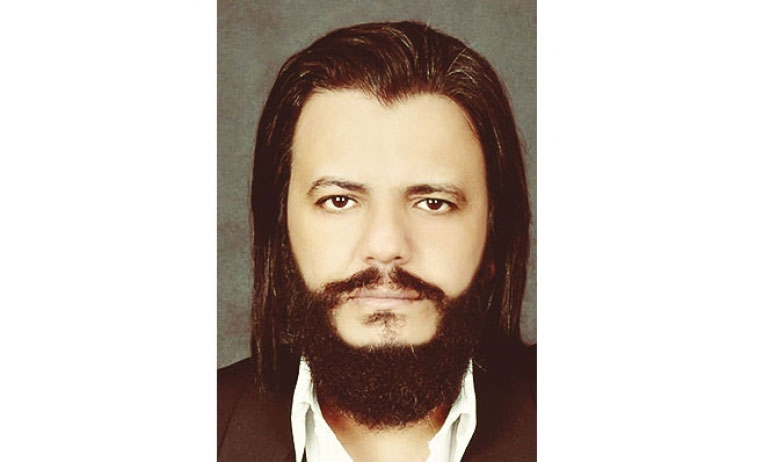اجتمعت الإنسانية على لغةٍ واحدة، واندفعت وراء حلمٍ طوباوي: تشييد برجٍ يلامس السماوات. لكن ذلك الشغف بالتوحيد لم يُفضِ إلا إلى التشتت والانهيار. العبرة هنا ليست دينيةً فحسب، بل سياسيةٌ بامتياز: لم يكن التنوع هو ما أسقطهم في الهاوية، بل الولعُ الأعمى بالنظام الأحادي. بعد آلاف السنين، لا تزال هذه الأسطورة تُلقي بظلالها على مأزقنا الحديث، كشاهدٍ لا يكلُّ على دوام الدرس.
شهد القرن الحادي والعشرون انهيار أوهام العالم أحادي القطب. فالهيمنة الأمريكية بعد الحرب الباردة، مثل صعود الصين الطامح، تصطدم اليوم بواقعٍ شبكي: لم تعد السلطة تتركز في قمةٍ واحدة، بل تتدفق عبر عقدٍ مترابطة. لم تكن بابل لعنةً، بل تحذيراً من مغبة السعي إلى مركزيةٍ مستحيلة. ومع ذلك، يستمر البعض في قراءة هذا القرن من خلال منظورٍ بالٍ يرى الهيمنات تتعاقب خطياً: بعد القرن البريطاني ثم الأمريكي، يُزعم أن "القرن الصيني" قد كُتب مصيره. تتجاهل هذه الرؤية الخطية الثورة الصامتة الجارية. لم يعد عصرنا يُرسم خرائطياً بمراكزَ وأطراف، بل بشبكاتٍ من القوى المتحركة: وادي السيليكون يزن بقدر دولٍ بأكملها، اليوان الرقمي يتحدى البترودولار، والنفوذ يُقاس بالخوارزميات بقدر ما يُقاس بالصواريخ.
لقد تجاوزنا زمن الاستعارة الهرمية البالية. النموذج العمودي الذي كان يوماً رمزاً للنظام يتهاوى اليوم بلا رجعة: العقوبات المالية تُراوغها تقنيات البلوكتشين، التسلسلات الهرمية التقليدية تتفكك تحت وطأة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والدبلوماسيات الحكومية تتجاوزها تغريدات المؤثرين. في هندسة القوة الجديدة، لم تعد القواعد العسكرية النقاط الاستراتيجية الوحيدة؛ صارت مراكز البيانات قلاع العصر، والخوارزميات أسلحةً تُعادل في تأثيرها فرقاً مدرعة.
يكرس العالم الشبكي مفارقةً عميقة: الاختلافات لم تعد عيوباً، بل أصولاً حاسمة. لم يعد مقياس القوة ارتفاع المنارة، بل كثافة الاتصالات. البلد القوي لم يعد حصناً منيعاً، بل محوراً لا غنى عنه، مفترق طرق للتدفقات العالمية. تفرض هذه الحقيقة نفسها بقوة: عصر الأنظمة الشعبوية المغلقة يعيش أيامه الأخيرة. هذه التعددية الفوضوية ليست فشلاً في الحوكمة، بل النتيجة المنطقية لبابل الحديثة. وهذه المرة، على عكس بناة البرج القديم، علينا أن نتعلم كيف نزدهر وسط التشتت.
أولاً. الهرم المستحيل: عندما ينهار النظام الأحادي
لطالما جسّدت بابل الحلم الإنساني بالعمودية، ذلك الطموح العنيد للصعود نحو قمةٍ موحدة تُحكم العالم من أعلى. لكن مع كل محاولة تاريخية لإحياء هذا النموذج – سواء تجسّد في إمبراطورياتٍ سياسية كالرومانية أو العثمانية، أو في رؤى دينية كالخلافة أو الحملات الصليبية، أو حتى في أيديولوجيات القرن العشرين كالشيوعية أو الليبرالية الغربية – ظهرت تناقضاته البنيوية التي قوّضته من الداخل. لم تكن هذه التناقضات مجرد إخفاقات عَرَضية، بل كشفت عن استحالة فرض نظامٍ أحادي على عالمٍ ينبض بالتنوع والحركية. لقرون طويلة، هيمنت الفكرة الهرمية ببنيتها الصلبة – قمةٌ واحدة تُصدر الأوامر، قاعدةٌ عريضة تُنفذ، ومسارات صعودٍ محددة تكرّس التسلسل – على المخيال الجيوسياسي للدول والإمبراطوريات. هذه البنية، التي بدت يوماً رمزاً للاستقرار، صارت تُنتج اليوم أزماتٍ متتالية، إذ تُصطدم صرامتها بتعقيدات عالمٍ لم يعد يقبل الاختزال إلى مركزٍ واحد. من سقوط روما إلى انهيار الاتحاد السوفييتي، تُظهر التجارب التاريخية أن الهرم، رغم جاذبيته، يحمل في طياته بذور تفككه.
1. حدٌ نظري: نظرية غودل
تواجه كل محاولة لبناء نظام عالمي متماسك حدوداً بنيوية لا تُتجاوز. في عام 1931، كشف عالم المنطق كورت غودل عن مبدأٍ جوهري: أي نظام هرمي يحتوي على قضايا "غير قابلة للحسم"، أي يستحيل إثباتها أو نفيها ضمن المنظومة ذاتها. عند تطبيق هذا المبدأ على العلاقات الدولية، يصبح تحذيراً صارخاً: لا يمكن لأي إطار حوكمة عالمي أو نموذج هيمنة أحادي أن يحتوي التعقيد البشري دون أن يفرز تناقضاته الداخلية. الهرم السياسي، بصرامته، يولّد حتماً مناطق عمياء في قاعدته وقمته على حد سواء.
ما كشفه غودل ينعكس في الواقع الجيوسياسي: كل مشروع يسعى إلى حصر التفاعلات الدولية في هيكلٍ مغلق ينتج بذور انهياره. من العملات الرقمية التي تتحايل على العقوبات إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تعيد صياغة الدبلوماسية، تُظهر الديناميكيات المعاصرة أن محاولات الهيمنة الأحادية تُفضي إلى ردود أفعال معقدة تُعيد تشكيل النظام بطرقٍ غير متوقعة. فعلى سبيل المثال، تتحدى تقنيات البلوكتشين النظام المالي التقليدي، بينما تُعيد منصات مثل إكس تشكيل الرأي العام بسرعة تفوق الحملات الدبلوماسية التقليدية. هذا التفاعل المستمر يكشف حدود النموذج الهرمي، ويُبرز الحاجة إلى بنيةٍ أكثر مرونة قادرة على استيعاب التعقيد.
2. استحالة عملية: استعصاء العالم على الاختزال
ظهرت فكرة النظام العالمي المركزي مراتٍ عدة في التاريخ الحديث. في القرن العشرين، تجسدت في المشروع الويلسوني مع عصبة الأمم، ثم الأمم المتحدة. وقبل ذلك، تبلورت في المخيلة الفلسفية لعصر الأنوار، عند إيمانويل كانط الذي حلم بسلامٍ دائم قائم على القانون، أو عند سبينوزا وتوماس الأكويني وحتى أفلاطون، الذين تصوّروا عالماً منهجياً ومنظماً. لكن هذه الرؤى، رغم طموحها، اصطدمت بحقيقةٍ مريرة: العالم يستعصي على الاختزال إلى هيكلٍ موحد. كلما حاولت الأنظمة المركزة فرض نفسها، زاد تفتت النظام العالمي. الأزمات المتتالية – من الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط إلى التحديات العابرة للحدود كالتغير المناخي والهجرات الجماعية – تُظهر أن حلم المركز الواحد لم يعد مجرد طوباوية، بل فخٌ يُعيق التكيف مع الواقع. فشل عصبة الأمم في منع الحرب العالمية الثانية، وتعثر الأمم المتحدة أمام الصراعات المعاصرة، يكشفان أن النماذج المركزية تفتقر إلى المرونة اللازمة لإدارة عالمٍ متعدد الأقطاب ومتشابك.
ثانياً. العالم في شبكة: نموذج جيوسياسي جديد
في خضم التحولات العالمية، تنهار الأبراج الشاهقة للسلطة التقليدية، تاركة المجال لبنيةٍ جديدة لا تقوم على السيطرة العمودية، بل على التداول والترابط الأفقي. مع تزايد تعقيد العلاقات الدولية، يتراجع النموذج الهرمي الجامد أمام ترتيبٍ شبكي ديناميكي يتسم بالمرونة والتوزيع. لم يعد العالم ساحةً لهيمنة القوى العمودية، بل فضاءً للتواصل والتفاعل. منطق الفرض والتحكم يتلاشى تدريجياً، مفسحاً المجال لمنطق الربط والتعاون.
1. اتصالات، احتكاكات، تعايشات
ما يتشكل اليوم ليس إمبراطوريةً جديدة، بل أرخبيلٌ من القوى المترابطة. واشنطن، موسكو، بكين، بروكسل: لم تعد هذه العواصم تهيمن من قمةٍ منفردة، بل تتداخل عبر تقاطعاتٍ ومنافساتٍ وتعاوناتٍ معقدة. حولها، تتشابك مناطق التوتر (أوكرانيا، الساحل، غزة)، والتحديات النظامية (الذكاء الاصطناعي، التغير المناخي، تدفقات الهجرة)، والفاعلون غير الحكوميين – من الشركات التقنية العملاقة مثل ميتا وتسلا إلى الحركات الاجتماعية مثل تلك التي أشعلت الربيع العربي – في نسيجٍ ديناميكي، غير مستقر لكنه مترابط.
الشبكة لا تعرف مركزاً وحيداً ولا محيطاً مطلقاً. كل عقدة – سواء كانت مركز بيانات في سنغافورة، ميناء استراتيجي في جيبوتي، قائد تكنولوجي مثل إيلون ماسك، أو منتدى إقليمي كآسيان – يمكن أن تتحول إلى مركزية حسب طبيعة التدفقات. هذه بنيةُ روابط، لا تسلسلٌ هرمي. الأنظمة المغلقة تتحول إلى مآزق، والهياكل الهرمية تتخبط أمام عدم اليقين. في عالمٍ متغير، تظل هذه الأنظمة جامدة، وهذا بالضبط ما يحكم عليها بالزوال.
2. من النظام الهرمي إلى الذكاء الموزع
يشهد عالمنا تحولاً جذرياً في أنماط الحكم والتنسيق العالمي. لم تعد المنظمات الدولية تعمل كأبراجٍ عاجية تفرض سياساتٍ من الأعلى، بل أصبحت منصاتٍ مرنة لتنسيق الجهود بين فاعلين متنوعين. سواء تعلق الأمر بمجموعة العشرين، مؤتمرات المناخ مثل COP28، أو تحالفات مثل البريكس، فإنها لا تُنتج هرمياتٍ صلبة، بل تسعى إلى توافقاتٍ ديناميكية تتكيف مع المتغيرات. الذكاء والسلطة لم يعدا حكراً على مراكزَ قليلة، بل انتشرا عبر شبكاتٍ من الخبراء، المجتمعات المدنية، المدن الذكية مثل دبي وسنغافورة، والتحالفات غير التقليدية كتلك التي تجمع شركات التكنولوجيا مع الحكومات.الفعالية لم تعد تُقاس بصرامة التسلسل الهرمي، بل بقدرة الأنظمة على التكيف، الربط بين الأطراف، والإنصات إلى أصواتٍ متعددة. ففي مواجهة أزمات مثل جائحة كوفيد-19، أظهرت الشبكات الدولية – من منظمة الصحة العالمية إلى تحالفات توزيع اللقاحات – قدرةً على التنسيق الأفقي تفوقت على الأنظمة الهرمية التقليدية. عالم الغد لن يُبنى من قمة هرم، بل من شبكةٍ مترابطة من العُقد الذكية، كلٌ منها تُسهم بقطعةٍ من الأحجية. القوة ستكون في تعدد المراكز، لا في مركزٍ واحد.
بابل معاد تأويلها: تعددية، لا توحيد
أسطورة بابل ليست لعنة الانقسام، بل تحذيرٌ من مخاطر التوحيد. فشل بناء البرج لم يكن بسبب تنوع البشرية، بل لأنها أرادت إسكات هذا التنوع. فهم عالم اليوم يتطلب إدراكاً أن النظام العالمي لم يعد يُبنى بتراكبٍ عمودي، بل بتشابكٍ أفقي. لن يكون القرن الحادي والعشرون قرن إمبراطوريةٍ عالمية جديدة، بل قرن عالمٍ مشبّك. أولئك الذين يعلنون موت العولمة يغفلون عن التحول الصامت لأشكالها. لقد سقط البرج، لكن الروابط تُنسج بلا توقف.
ربما تكون هذه هي الحكمة الجيوسياسية الحقيقية لعصرنا: إدراك أن القوة لم تعد تُقاس بارتفاع هرم، بل بقدرة شبكةٍ على استيعاب تعقيد العالم والازدهار وسط تعدديته.