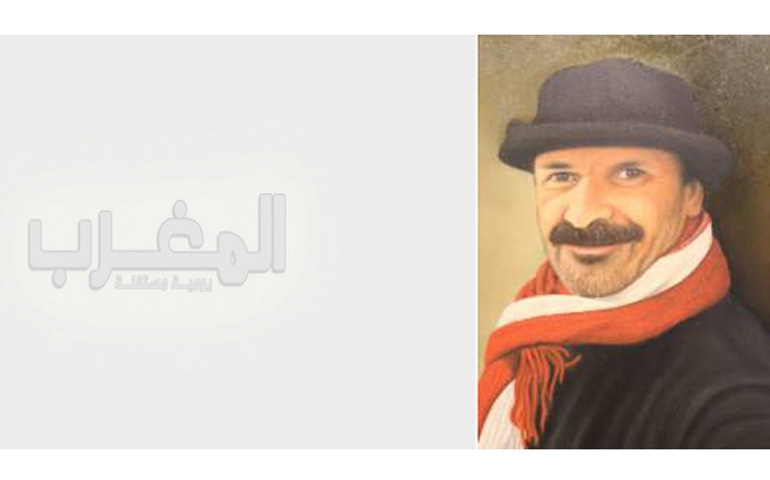«قفوا وأنتم جالسون هُنا سَواعِدكم مَعْقودَةٌ والعَالم يجْري نحو الضّياع .قال الربُّ: ليس بخورا أُريدُ ولاَ صلواتٍ ولا لحْــما . افْتَحوا مَـخازنكم ووزّعوا الخُبزَ على الفُقراء وانْتشروا في الأرْض لتُعلنوا كلمة المسيح: المحبّة والعَدالة والسّلاَم « ( كتاب الأخوة الأعداء )
اشارة من عالم الأنتروبولوجيا كلود ريفيار( كتاب الأنتروبولوجيا الاجتماعية للأديان ):
«يمكن للإنسان أن يعْتقِد في شيءٍ ما على مُستوى الوعْــي لكنّه يعْلم عن طَريق اللاّوعي أنه خَطأ..».
(1)
قَاتِلَةٌ هي بَعْضُ « اُلْمُثل العُلْيا « في تَاريخ الحَضَارات كلّها... ولدَى كل الشّعوب « حنينٌ خَفي « و» نوستالجيا سريّة»
«لزمن ذَهبي» «ضائع» يُــراد اسْتِعادته بتَحْيينه كلّف ذلك ما كلّف من إراقة الدم البَشري باُسم «المثل المقدس» الذي تم تَدْنيسُه و«الأنمودج الأعلى» الذي تم تحْطيـمه.. رغم «مكر التاريخ» ومُـمَانعاته في حينِ أن لا أزْمِنة ذهبيّة قد عَرفتها البشريّة في أية حَضارَةٍ من الحَضارات... وأن كل «المثل العليا» النبيلة من جهة التأسيس استحالت إلى أدوات ومبررات «للجريمة» البشرية ضد البشرية... وأصبح من المعقول والشرّعي طرح السؤال الحاسم:
هل يجْدر بنا أن نتبنّى لنا «مثلا أعْلى» دون مساءلة نقدية تضعُ احترام واحتراميّة الإنسان هي المقياس والبوصلة والمحرار أم نواصل الانقياد الأعمى لإملاءات سوانا ؟
(2)
يـَبدو- دون اُعْتقاد - أن اُلْإستنطاق النقدي الجينيالوجي الـمُركبّ للمُتون الحَضارية في صِيغها اُلْـمُتعدّدَةِ واُلْـمُتَباينَة والمختلفة - ومن أي أُفق نظَري تمّت مُقاربتها دَرْسا مَنْهجيا ودِراسا معرفيا - يبيّن لنا أن جَميعها قد اُنْبتْ من جهة التأسيس التدْشيني على تصوّر مخصوص للإنسان والحيوان والله - الآلهة والزّمن والحياة والموت وما يستتبع ذلك من قيم أُلْفة وإيثار أو قيّم كراهية واسْتنفار... وفق رؤية للعالم ناظمة للوجود والموجود, الموجود العيني في تجلياته الحسيّة أو في انوجاده الإعتباري اللاّمرئي كما فكرة «الإندثار» و«التفكّك» و«الفناء» أو فكرة «الخلود» و«الديمومة» و«البقاء». من أخص خصائصها هذه الرؤية أو تلك أنها رؤية صَارِمة وان هي توسّلت بأكثر الاستعمالات الشّعرية للغة كما هو الشأن في الأساطير القديمة أو الأساطير الحديثة لا تُفرّط في «شيءٍ» من شأنه أن يُربك نِظام انُعِقَادِهَا وعُقودِها التي تجدُ فيها هذه الشّعوب أو تلك «تفسيرا» و«تبريرا» لعِلّة وجودِها في الوجود ولمعضلات الكون والمحيط وتَعَاقُب الفصول ومحنة الحياة والممات». كان علم الفلك المصري - مثلا - يعتمد على تداخل أربعة عناصر رئيسية: ماء المحيط ثم (الإله تَفْنُوتْ) والنار المتمثلة في االشّمس (أتوم) والهواء المتمثل في السّماء (نوتْ) والأرض (جِيب) أخْت (نوت - السّماء ) وقد خُلقَت هذه العنَاصر نتيجة للحُبّ بين الهواء والرُّطوبَةِ ( تفْنوت وشُو ). وكان مَركب الآلهة الذي يحتفل به الدّين الرسمي من قبل فرعون يشتمل اشكالا متعدّدة مُستوحاة من مملكة الحيوانات: آلهة برأس قطة أو ابن آوى أو عقابا أو كبرى الأفاعي أو بقرة أو كبشا ..» ان للأساطير «بُناها الذهنية» التي تتسلل في «اللاّوعي المعرفي» وحتى العاطفي لدي أكثر الكائنات «علمنة» و«حداثة».
لذلك رُبـّما نجدُ في كل الحَضارات «السّاخنة» «مثل عليا» عاملة فاعلة تمارس الإقصاد والكبت والإغتياب والإغتبال.. كما في الحضارات «الهادئة الصّامِتة» الـمتَقشفة في لغْو الكلام أو «البروميثوسية - الناريّة النبّاحة عند اعلان الحرب الباردة» أو «الحامية» أو عند قَذائِف الإشْهار النّاعم و الإشهار الأحْرش في جميعها تعمل «مثل عليا» تشطر العوالم بكل خلقه ومخلوقاته إلى شطرين وفق منطق «الصفاء» كما «الصفاء العرقي» أو «الصفاء الخضاري» أو «الصفاء الجنسوي» التصفوي. في كل الحضارات ثمة ما يمكن لي تسميته «مخازن للمَفَاخِرِ» ومخازن «أُخْرى للمَخَازِي». «مثل عليا «تظهر أجْلى ما تَظْهر في أزْمنة السّنوات الرّغيدة أو أزْمنَة تِلك السّنوات الكَبيسَة الشّقْشاقة بالشّقاء. أما أزمنة البين بَيـــن» في تاريخ الشّعوب وحَضارات الشّعوب فهي صَفحَات أقْرب لأن تـَكُون صَفَحات مائيّة «لا لون ولا رائــحة»... وغالبا ما تَسْقُط من الذاكرة الجماعية الجامعة للجماعة لذلك لا تحْتفظ البشرية من تاريخها أحيانا إلاّ بما تـَمّت «كتَابته» حفرا وكــيّــا ووشْما وَرَشْـمًـا و وَسْـمًــا على جَسَدها جِلْدا ولحْـــمًـا. قد ثبّتَتْه « بالحديد الـمُحَمّى والقَطِران
السّاحن» وفق عبارة صاحب «جينيالوجيا الأخلاق» (نيتشة). مع الأخذ بعين الاعتبار المعرفي - الإبستيمولوجي ما كان قد أطلق عليه(مِرسيا الياد) يـحِذْق» قانون تلاقي الأضْداد الذي يعمل دائما في الخفاء «كأن تأكل الثّورات- مثلا - أبناءها» وتتلّبس «بِنْية المقدّس عقول مُنكريها»... ويغدو «الملحد» أكثر تعصّبا و«ايمانا» ويصبح «المؤمن أكثر دنيوية وشهوانية و«كُفرانا» وباُخْتصار يحدث للأضداد أن كما يقول اللسان الحكيم: «اذا بلغ الشيء إلى حدّه انقلبَ إلى ضِدّه «فيتقمّصُ «الشَبَحُ» صُورة الشّخْصِ بعْد أنْ يـَكُون قدْ أكل الشّخْصَ - مثلا- أو أن الشّخْصُ عينه يكف على أن يكون هو نفسه صنْو نفْسه و يتّخِذَ لهُ صُورة القِناع ليحُولَ بينَه وبين مَعرفة نَفْسه بنَفْسِه لأن المعرفة يمكن أن تكون جارحة وقاتلة . نطق أوديب الأسطورة على لسان الشاعر الفلسطيني: « ما حاجتك يا أوديب للمعرفة ؟» وما يجوز على الأفراد قد يجوز على الحضارات بصيغ مختلفة تتفكك «الهويات» التي كان يُظنُّ لزمنٍ طويل أنها «وحدة صماء» كما «البنيان المرصوص» صلبة التّـمْكينِ في التّكْوين وتَشْتَبِكُ الأدوار المنْظون بكَونها تَكَونّت نهائيا وتشكّلت مرّةً واحدةً وإلى الأبَدِ لأنّ
الفكر البشري يخافُ البشري يخاف حدّ الرّهَابِ من «المتحرّك» ذلك العَصيّ على «الإسْتِكْناه» و«الضّبط» و«القياس» و«الوزن» و«الحَصْر» و«الحدّ» و«التقدير» و«التّدْجين» والإعْتقال بسُلطة العقل وسُلطانه... ولذلك ربما كان الله «ليس كمثله شيء «وحده» لا تعْزب عنه مثقال حبّة خرذل و«الجنة لا عينَ رأتْ ولا أُذن سَـمعت ولا خطر على قلب بشر»... حتى أن الشَطَطَ في «التفكير» يُنظر إليه من منظور «الكوجيطو الايماني» (أنا مؤمن إذن أنا موجود) على أنه «تطاول على الحُرمة الإلهية» أو هو عصيان للسلطة الإجتماعية. تطاولٌ بلا طائلة على غير المقدور عليه ... الذي بحكم طبيعته يجب أن يبقي «لغزا» بل هو «لغْزُ لُغْزِ الألْغاز» وإلا لما بقيت لكل أشكال التّعاقد مع «اللاّمرئي على» الطاعة والإمتثال «من دلالة تجعَل منه هوّ وحده دون سواه سلطة السّلط و - البوصلة والدليل في الرؤية» الإيمانية - الروحانية للعالم «كما في المعتقد الكُلياني - المحتشداتي - الشّمولي في السياسة . ذلك الذي يتأسّس على «مثل أعلى» يُصادر حرية التفكير النقْدي والتّعبير الحر والتدبير الإبْداعي في مقابل فلاحة ثقافة الإمعيّة والإمتثال والسماع والإتباع... ((أنّه فكّر وقدّر فَقُتِل كيْفَ قدّر ثم قُتل كيف قدّر...)) وفق عبارة المعجم القرآني الرائعة «وانْ هوّ السّياق ليْس السّياق».
(3)
ما يعنيني بشكل رئيس حين هذا الحين هو كون «المثل العليا» ( الحب، العدل، الحرية، التقدم، الحقوق، الإخوّة، التنوير، التحرير، والتحرر.. الديمقراطية ) التي تتخذها الإنسانية الحالمة لتقي ذاتها من شر ذاتها سرعان ما تنقلب البشرية بها عليها . فتستحيل حدائق النِّعَمِ إلى بَراكين نِقَمٍ لواحة بالبَشر في كلّ الجِهات والإتجاهات وتزدهر ثقافة المناحات والنّدم، ويعاود البشرية سؤال الملكة بلقيس- من أدانت فساد الملوك - للملك سليمان: «ما لوْنُ اُلْــرَبّ»؟، «الإخوة الأعداء» كل يشهر في وجه أخيه «مثله العليا» من أجل ابتزازه وامتهانه والفتك به ليس للخلاص من الفقر وأوْجاع «الحاجة» وإنما «للإستطابة».
(4)
«المسيح لا يُرضي حَاجَتي بالحَالةِ التي جعَلوه علَيها... بملابِس الذهب والقُصور التي يقيمون بـِها الحَفلات في المسَاء مع سَادَة هذِه الدُنيا . أنا أتحرّق شَوقا إلى مَسيح حافيَ القَدمَين . جائع ومقْهور شبيهٌ بهذا الذي لقيّهُ الحواريّون على طريق عَمواس... فرسالة المسيح قد هَانت واُنــْمَحَت آثاره المقدّسَةُ من الأرْضِ . نحْن لا نتّبع اليوم إلاّ أثار المنَافقين ذوي اللّحى . الآثار التي تَركَــتْـها في الوَحَلِ حَوافر الشّيْطان . لقد قَلَبوا كلمات المسيح فجعلوها :( « طُوبى لقساةِ الرّوحِ لأنّ لهُم ملكوت الأرْض. طُوبى للمُتكبّرين لأنّـهم يَـرِثون الأرْضَ .طوبى لِلْجياع واُلْعَطاشى إلى اُلْظُلم . طُوبى لمن لا يـَرْحَمون . طُوبى لمنْ لهُم قلْب دَنِسٌ .طوبى لصَانِعي الحُروب»).
هكذا أنْطَق الرّهيف (نيكوس كازنتزاكيس) الرّاهِب الشاب «نيكوديم» في خطاب توجّه به إلى القسيس العَجوز الأب «ياناروس»... ياله من حُلم «بالمثل الأعلى» يقول صاحب «المواقف والمخاطبات» المتصوف العِرفاني الكبير عبد الجبار النّفري الحالم «بمثل أعلى» هو بدوره وعلى طريقته:
«أوْقَفَني في الإختيار وقال لي: كلّهُم مَرْضى.
وقال لي هو ذا يدْخُل الطِبّ عليهم بالغَداة والعَشي واخاطِبـُهُمْ أنَا عَلى ألْسِنة اُلْطبّ ويعْلمون أنّيَ أنا أكلّمهم ويعِدُون اُلْطبّ بالحِـميَة ولا يعِدُوني».
(5)
هل يجْدر بنا أن نتبنّى لنا «مثلا أعْلى» دون مساءلة نقدية تضعُ احترام الإنسان في الوطن وفي العالم هي المقياس والبوصلة والمحرار أم نواصل الانقياد الأعمى لإملاءات سوانا ؟ ومتى تغلق البشرية المسلحة .. مخازن مخازيها ؟
لا أملك الكفاءة الكافية للإجابة الشافية . قد نظفر بالاجابة المطابقة في كتاب ميشال لوكوا ».
« A voir un idéal est - ce bien raisonnable »