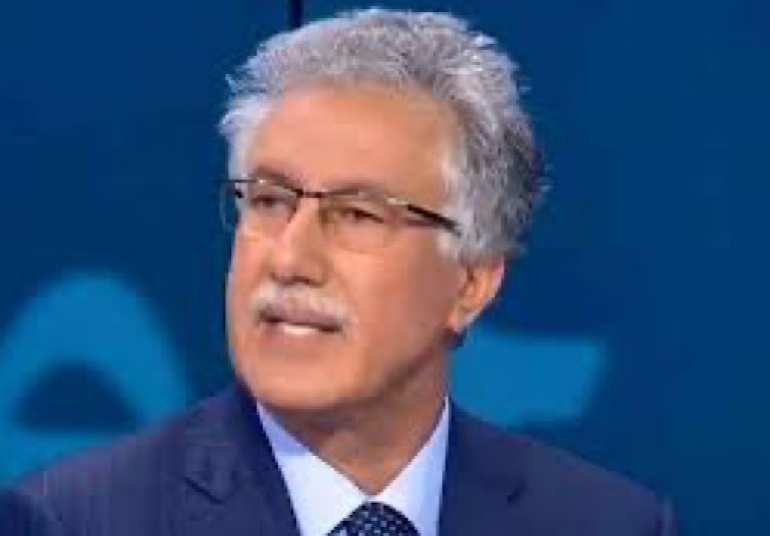صراع مع المرض. ودّعنا أحد أبرز رموز الفنّ في تونس خلال العقود الخمسة الأخيرة. ترك الفقيد إرثا هامّا في مجالات برع فيها وترك فيها جميعا بصمته وهي المسرح والسّينما وما يمكن أن نسمّيه فنّ الفرجة وأقصد هنا أعماله الضّخمة الخاصّة بالتّراث التي أخرجها بأسلوبه الاحتفاليّ المتميّز.
ليس هدفي في هذه السّطور العودة إلى أعماله الكثيرة والمتنوّعة ولا تقييم مضامينها أو الحكم عليها فنّيّا فثمّة من هم أقدر منّي على القيام بذلك. كلّ ما أريد هو أن أحكي بعض الذّكريات متعدّدة الأبعاد التي جالت بخاطري وأنا أحضر جنازة الفقيد إلى جانب عدد كبير من أصدقائه وصديقاته الذين ساهموا في أعماله أو الذين تابعوها وأحبّوها.
لم ألتق فاضل الجزيري مباشرة إلّا خلال أيّام فيفري 1972 العاصفة. قبل ذلك لمحته ذات مرّة في التلفزة الوطنيّة في صائفة 1971 على ما أظنّ. كان ذلك بمناسبة عرض مسرحيّ في «الحفصيّة» بالعاصمة، في الهواء الطّلق. كان هدف فاضل وقتها إخراج المسرح من فضائه الخاصّ بالمسرح البلدي إلى «الشّارع»، إلى «الحومة» الشعبيّة حتى يتمكّن عامّة النّاس من التمتّع به وبالثقافة عامّة التي ظلّت حكرا على جمهور معيّن.
تعود إلى ذاكرتي صورة فاضل بقامته الفارعة وشعره الطويل وهو يجول فوق الرّكح. كان الزمن وقتها زمن «الهيبيز» وموسيقى البوب، والرّوك، والفولك وغيرها من أشكال الموسيقى الشعبيّة. زمن الحركات الشبابيّة الكبرى التي هزّت العالم والتمرّد على السّائد في اللّباس والتّقاليد والقيم والفنّ. زمن الانتصار إلى قضايا الشعوب المضطَهدة وعلى رأسها قضية فيتنام التي حرّكت العالم أجمع تماما مثلما تحرّكه اليوم القضية الفلسطينيّة. وكان جيل كامل من الفنّانين الكبار في ذلك الوقت من بين من وقفوا بفنّهم ومواقفهم في وجه الوحش الامبريالي الأمريكي المجرم على الدّوام.
في خضمّ حركة فيفري 1972 الطلّابية التقيت فاضل مباشرة. كان ذلك في شقّة بالطّابق الأوّل من عمارة في نهج إنجلترا بالعاصمة. عند صديق مشترك «حاجّي» (نور الدّين محفوظ). كنّا نلتقي لنناقش كيفيّة توسيع الحركة الاحتجاجيّة الشبابيّة لتشمل المعاهد الثانويّة. وكانت تجلس معنا «دليلة»، شقيقة «حاجّي»، وكانت وقتها تلميذة بمعهد الفتيات نهج الباشا وهو المعهد الذي سيعطي إشارة انطلاق الحركة التّلمذية بالعاصمة إثر خطاب تحريضي ألقته دليلة وسط زميلاتها.
كان «سي رابح محفوظ»، والد «حاجّي» ودليلة، يرافقنا أحيانا في نقاشاتنا لينصحنا. كان «سي رابح» نقابيّا معروفا، صديقا لحشاد والحبيب عاشور، وكلّهم من أبناء قرقنة. كانت آخر مرّة التقينا فيها ليلة 9 فيفري 1972. ليلتها تمّ اعتقالي وأنا عائد إلى «مخبئي» في نهج السودان ليس بعيدا عن سوق باب الجزيرة.
لم أرَ فاضل مجدّدا إلّا بعد إطلاق سراح كلّ الموقوفين، وكان عددهم وقتها بالمئات، بسبب المشاركة فيما أصبح يعرف تاريخيّا بحركة فيفري المجيدة التي جاءت ردّا على انقلاب طلبة الحزب الحاكم على أغلبية نوّاب مؤتمر قُربة للاتّحاد العام لطلبة تونس الذين كانوا على وشك فرض استقلاليّة منظّمتهم عن طريق الانتخاب لتكون أوّل «منظّمة وطنيّة» تخرج من تحت وصاية حزب الدّستور القسريّة. من وقتها ستتوطّد علاقتنا خاصّة أنّنا كنّا ننتمي إلى نفس الفضاء اليساريّ ونتعاطف مع نفس الحركة (آفاق-العامل التّونسي).
في صائفة 1972 سيلتحق فاضل بمدينة قفصة ليؤسّس مع ثلّة من المسرحيّين المتمرّدين «فرقة مسرح الجنوب». كانت الفكرة مرّة أخرى الاقتراب من عامّة النّاس، وذلك بالخروج بالمسرح من «المركز» إلى الجهات في إطار توجّه تقدّمي يرى أنّ الثقافة ومنها المسرح، «شعبيّة أو لا تكون». إنّ الذين غادروا العاصمة في اتّجاه قفصة، لتأسيس «فرقة مسرح الجنوب» هم غالبيّة الذين سيعمّرون المشهد المسرحيّ والسّينمائي والتّلفزيونيّ على مدى عقود.
الفاضل الجزيري وفاضل الجعايبي ومحمّد رجاء فرحات ومحمّد إدريس وجليلة بكّار ورؤوف بن عمر وسمير العيّادي وحمّادي بن عثمان يضاف إليهم «أبناء الجهة» عبد القادر مقداد والأزهر مسعاوي وعبد القادر الكك وعلي النايلي والهادي الدّالي، التقى جميعهم حول مشروع فنّي، ثقافي جادّ وجديد...وكانت ثمرة عملهم الأولى مسرحيّة «جحا والشّرق الحائر» التي ستتلوها أعمال أخرى خَلَدَتْ في الذّاكرة.
في سنة 1973 عرّفني فاضل الجزيري و«حاجّي» بالمخرج السّينمائي عبد اللّطيف بن عمّار الذي فارقنا سنة 2023. أقنعه فاضل و«حاجّي» بأن يكون سيناريو شريطه الجديد «رسائل من سجنان» الذي يتناول لحظة مفصليّة من تاريخ الحركة الوطنيّة (1952)، باللّهجة العاميّة التّونسيّة لا بالفرنسيّة. ولمّا سألهما عمّن سيساعده في هذا العمل رشّحاني مباشرة لهذه المهمّة.
كان الشّغل مع عبد اللطيف بن عمّار طوال صائفة 1973 بشقّته بشارع باب الجزيرة، ممتعا للغاية. علّمني بسرعة تقنيات السّيناريو وانطلقنا في الإنجاز. قام «حاجّي» بدور البطل في ذلك الفلم إلى جانب ثلّة من المبدعين القدامى والجدد أمثال فاضل الجعايبي ومنى نور الدّين ونور الدين القصباوي وأحمد السّنوسي وكمال التواتي وغيرهم.
في تلك الصّائفة كنت أتخفّى عن أنظار البوليس السّياسي وأتنقّل بحذر شديد. التحقت منذ أشهر «بمنظّمة العامل التّونسي» اليساريّة . وطلب منّي «التّنظيم» في بداية الصّيف إيجاد «كَرْيَة» في منطقة معزولة نسبيّا لأشكّل غطاء لرسّام الكاريكاتور الشّهير، مصطفى المرشاوي، صديق فاضل وغالبيّة مثقّفي العاصمة ومبدعيها، الذي كان محكوما غيابيّا ومبحوثا عنه من البوليس السّياسي بسبب مشاركته في تهريب الماضلين الشّهيرين في ذلك الوقت، محمّد بن جنّات ودليلة بن عثمان، عبر البحر. وقد وجدت ضالّتي بمساعدة صديق شقيقي الأكبر، الطّاهر، الجامعي والأديب سالم ونيّس، الذي ترك لي في شكل «كَرْية من تحت كَرْية» (en sous location)، «ستوديو» كان على ذمّته في منطقة العمران لنسكنه، مصطفى المرشاوي وأنا، مدّة العطلة الصيفيّة.
لم يكن ذلك هو السّبب الوحيد الذي دفعني إلى اتّخاذ احتياطات أمنيّة خاصّة، فقد كان الجوّ السياسي العام متوتّرا وكنّا في «العامل التّونسي» نتوقّع حملة قمعيّة قريبة لتدجين اليسار المتنامي والحركة الطلّابية العنيدة، التي أعادت تنظيم صفوفها بعد قمع فيفري 1972 وأنشأت خلال السّنة الجامعيّة الجديدة، «الهياكل النّقابيّة المؤقّتة»، لتأطير نضالاتها التي لم تشمل في تلك السّنة المطالب الطلّابيّة فحسب وإنّما شملت أيضا مساندة العمّال (أذكر خاصّة إضراب عمّال النّقل بالعاصمة-ماي 1973) في نضالاتهم المشروعة تكريسا لشعار «الحركة الطلّابيّة جزء من الحركة الشّعبيّة» بالإضافة إلى مساندة ضحايا القمع السّياسي. وكان تأثير قوى اليسار وفي مقدمتها «العامل التّونسي» في تلك التحرّكات الطلّابيّة بارزا للعيان.
ألقى بورقيبة في صائفة 1973 خطابا عدوانيّا أمام المشاركين في ملتقى سنويّ للعمّال المهاجرين. كان متوتّرا للغاية وكانت لهجته حادّة، تهديديّة تنبئ باقتراب «المواجهة». تحدّث بورقيبة في البداية عن «الإدمان على الخمر وشربان الشّراب» ودعا المهاجرين إلى الإقلاع عنه لما فيه من مضرّة «بالمعدة والكبدة والصحّة والمال». وفجأة انتقل إلى موضوع آخر...سياسيّ لا علاقة له بالأوّل إلّا من زاوية توصية الحاضرين بالابتعاد عنه مثل «ابتعادهم عن الخمر» وهو ما كشف أنّ حديثه عن الخمر لم يكن سوى ذريعة (لَهْقَة كما يقال بالعامّية) للحديث عن «تعليماته» بخصوص الموضوع الثاني.
قال بورقيبة: «الشّيء الثّاني اللّي نحبّ نعطيكم تعليماتي باش تتجنّبوه باش تبعدو عليه...ثمّة معاكم من المهاجرين خدّامة أو طلبة، ثمّة بعض جراثيم يحبّو يبثّو السّموم متاعهم فيكم، يحبّو يخلقو انحراف سياسيّ ويبعدُوكُمْ عن الوطن متاعكم بْها الجرائد هذيّة اليوميّة...الأسبوعيّة (مسك بورقيبة بنسخة من جريدة العامل التونسي التي كانت أمامه على الطاولة ولوّح بها أمام الحضور) اللّي كلّها ثلب وشتم وكذب وبهتان هذي اللي قريتها اللي عنوانها العامل التونسي كلّها ثلب... تتذهم فينا بالفاشستيّة... وأننا نحن نخدمو في البورجوازيّة وفي الرّأسماليذة...».
هذا ما قاله بورقيبة عن معارضيه وقتها واصفا إيّاهم بالجراثيم ومتّهما إيّاهم بالكذب والبهتان واحتراف السبّ والشّتم وبث السّموم وخيانة الوطن وهو نفس ما يردّد اليوم من عبارات تجاه معارضي سلطة الانقلاب ومنتقديها ممّا يؤكّد أنّ لغة الاستبداد والمستبدّين واحدة في كلّ مراحل تاريخ بلادنا. «الجماعة قارين عند نفس المدّب». كان واضحا إذن من خطاب بورقيبة أنّ قرار شنّ حملة قمعيّة على «منظّمة العامل التّونسي» قد اتُّخِذ مع العلم أنّ بعض قادة المنظّمة التّاريخيّين (نور الدّين بن خذر، جلبار نقّاش...) كانوا بَعْدُ رهن الاعتقال.
في تلك الصّائفة، وفي نفس الفترة التي ألقى فيها بورقيبة خطابه، عُرضت مسرحيّة في مهرجان قرطاج الدّولي بعنوان «محمّد علي الحامّي» من إنتاج فرقة مسرح الجنوب. كان فاضل الجزيري أحد أبطالها. وكان ثمّة في أحد فصولها عرض فوق الرّكح لمظاهرة عمّاليّة احتجاجيّة. كان الممثّلون ومن بينهم فاضل يهتفون فوق ركح مسرح قرطاج أمام آلاف المتفرّجين: «عاش العامل التّونسي...عاش العامل التّونسي». ما من شكّ في أنّ اللّقطة كانت تعكس في الظّاهر حدثا تاريخيّا له علاقة باستقبال العمّال لمحمّد علي الحامّي في أحد تنقّلاته. لكن لم يكن ليخفى عن كلّ متابع للشّأن العام وقتها أنّ القصد من تلك اللّقطة «قصدين»، واحد في الظّاهر والآخر في الباطن، وأنّ هذه «العَمْلَة» لا يستغرب أن تكون من «عمَايِل» فاضل الجزيري. وهو ما أكّده بنفسه لاحقا لأصدقاء مقرّبين منه. وكان في تلك الحركة نوع من الجرأة والتحدّي.
مرّ الصّيف وجاء الخريف. وفي شهره الثاني أي في نوفمبر انطلقت الحملة القمعيّة «المبرمجة» على يد وزير الدّاخلية آنذاك الطّاهر بلخوجة وأعوان «سلامة أمن الدّولة» (البوليس السّياسي التّونسي) التي تأسّست في النّصف الأوّل من ستّينات القرن الماضي إثر «المحاولة الانقلابيّة» التي ارتبطت باسم قائد المقاومة أو «جيش التحرير الشعبي التونسي»، الأزهر الشرايطي. وقد عرفت هذه الإدارة التي تمّ حلّها بعد ثورة 2010 - 2011 بوحشيّتها وعدم خضوها لأيّة رقابيّة وإفلات أعوانها التام من أيّ محاسبة. وقد طالت الإيقافات المئات ممّن كانت تحوم حولهم شكوك الانتماء إلى «منظمة العامل التّونسي» أو إلى أي تنظيم يساري آخر وكان فاضل أحدم. كما طالت العشرات من قيادات الحركة الطلّابيّة. كان التعذيب الوحشي «الوجبة» الوحيدة التي يتناولها في مقرّات «أمن الدّولة» كلّ الموقوفين دون «تمييز» على أساس الجنس أو اللّون أو الانتماء الاجتماعي. كانت «المساواة» في ذلك العهد تتحقّق في هذا المستوى دون غيره.
ومنذ شهر ديسمبر 1973 بدأت إدارة « أمن الدّولة» عمليّة «تغربيل». أطلق سراح البعض ممّن لم يثبت انتماؤهم إلى «العامل التونسي» وفي نفس الوقت لم يكن لهم نشاط داخل الجامعة ومن بينهم فاضل. وبعد مدّة، وتحديدا في بدايات شهر جانفي 1974 تمّ توجيه كل القيادات الطلّابية «غير المنتمية» إلى ثكنات الجيش لتخضع للتّجنيد القسري. لقد كان التجنيد الإجباريّ شكلا من أشكال العقاب عند كلّ الأنظمة الاستبداديّة بدءًا من قيصر روسيا في القرن التّاسع عشر ووصولا إلى نظام بورقيبة. لقد عرفت تونس هذا الشّكل من العقاب لأوّل مرّة في أواسط ستّينات القرن الماضي (1966) إثر تحرّك طلّابي احتجاجا على إيقاف أحد الطّلبة، الرّاحل هشام قريبع الذي سيصبح في تسعينات القرن الماضي عضوا في الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان. كان ذلك إثر مشادّة بينه وبين مراقب في حافلة النقل. وقد سمّيت هذه الحادثة في تاريخ الحركة الطلّابية «بحادثة «الكار ».
نزل الطلّاب بعفويّة إلى شارع الحبيب بورقيبة هاتفين: « Démocratie…Démocratie… Démocratie». اعتقل البوليس قرابة 30 منهم واقتادهم إلى « القرجاني » الذي كان وقتها تحت إشراف « الحرس ». أُخليَ سبيلهم بعد أسبوع من الإيقاف عدا الطّالبين خميّس الشمّاري وعبد العزيز كريشان اللّذين اقْتِيدا إلى «ثكنة الجيش» ليُجَنَّدَا قسْرا. وقد كانا في ذلك الزّمن من بين العناصر الأكثر «تسييسا» في صفوف الطّلبة الذين بدأوا يضيقون ذرعا بأجواء الاستبداد الخانقة.
أمّا حملةالتّجنيد الجديدة التي تمّت في مطلع سنة1974 فقد شملت غالبيّة أعضاء «اللّجنة الجامعيّة المؤقّتة» التي كانت تمثّل القيادة المركزية للحركة الطلّابية كما شملت حزامها من كوادر الحركة في مختلف الكلّيّات. وكان من بين المجنّدين على ما أتذكّر مختار الطّريفي والأخضر لالة والنّوري عبيد وفرج منصور ومنصف الأسود ومحمّد جمور وعبد السّلام المكوّر (شهر الجنرال جياب) ونور الدّين الحفصي والهادي العيّادي وعبد المجيد بن عبد اللّه وغيرهم.
أمّا المناضلات والمناضلون الذين «ثبت» انتماؤهم إلى العامل التّونسي وبعض المجموعات اليساريّة الصغيرة فقد نُقلوا إلى سجن «9 أفريل»، بعد أن تعرّضوا لصنوف شتّى من التّعذيب الذي خلّف لبعضهم آثارا أبديّة، ليحالوا لاحقا (أوت 1974) على محكمة أمن الدّولة بتهمة «التّآمر» (قضية الـ202). وهي من التّهم الشّائعة حتّى اليوم ممّا يؤكّد أنّ الاستبداد لم ينته. وتجدر الملاحظة إلى أنّ «التنظيم» وجّه، منذ انطلاق الحملة القمعية،تعليماته إلى جميع الأعضاء، بالدخول في السرّية المطلقة وعدم الظهور في الأماكن العامّة وتغيير مقرّات السّكنى وإجراء الاتّصالات واللقاءات في أماكن آمنة وفي شكل مجموعات صغيرة جدّا مع التّركيز على الاتصالات غير المباشرة عبر المراسلات الصغيرة المكتوبة على ورق شفّاف «papier pelure» والملفوفة «بالسّكوتش « والقابلة للإتلاف أو الابتلاع بسرعة. وقد مكّن هذا التكتيك العشرات من المناضلات والمناضلين من الإفلات من الإيقاف وتأمين استمراريّة التّنظيم.
كنت وقتها أتسوّغ مع رفيقي الرّاحل محمّد الخميلي «استوديو» في نهج «البرتقان» بباردو بعد أن تركت استوديو العمران. ولم يكن يعرف المكان الجديد (شُهر «العِشّة) أحد باستثنائنا نحن الإثنين. فقرّرنا إيواء 4 من رفاقنا الملاحقين في نفس المكان (علي مقديش، منصف بن حسن، محمد معالي، صالح «س»…) على أن يبقى هو معهم وأبحث أنا عن مكان آخر للاختباء. توجّهت وقتها إلى فاضل الذي لم يمرّ على إطلاق سراحه سوى مدّة قصيرة وكان يسكن هو زوجته في شقّة اكترياها حديثا (لا يعرفها البوليس) بعمارة في نهج المعزّ بالمنزه الأوّل. لم يتردّد فاضل وزوجته لحظة في إيوائي وتركا لي حرّية التصرّف في أوقات الخروج والدّخول. وقد أسعدتني ثقتهما بي كما أسعدتني شجاعتهما واستعداداهما لتحمّل المسؤولية وبعبارة أدق استعدادهما للتضحية بحرّيّتهما في حالة تفطّن البوليسي السياسي إلى وجودي عندهما. كان التّعذيب والسجن في انتظارهما.
بعد مدّة قصيرة تمكّنت من إيجاد مكان آخر للاختباء. أعلمت فاضل وطلبت منه إن كان مستعدّا لإيواء رفيقين آخرين (علي مقديش ومنصف بن حسن) كانا محلّ ملاحقة من «أمن الدّولة» في انتظار أن يجد لهما «التّنظيم» مخبأ «مستقرّا». قبل فاضل دون تردّد. ومكث الرّفيقان عنده إلى أن تمكّن التنظيم من اكتراء محلّ لهما بمعيّة محمّد معالي (الصحفي) في «المدينة العربي»، وتحديدا في زنقة الطبّاخ، نهج النّفافتة، حيث بقيت تنظيميّا على اتّصال بهم لمدّة من الزّمن. لم يكن فاضل يعرف وقتها أسماء رفاقي (أنا نفسي كنت أعرفهم بأسمائهم الحركيّة فقط) بينما هم كانوا يعرفونه جيّدا كممثّل وفنّان إضافة إلى أنّه كان اعتقل لمدّة قصيرة في ربيع 1973 ضمن ما سمّي وقتها مجموعة الـ»MDM » (الحركة الديمقرتطية الجماهيريّة) وهي محاولة تنظيميّة أجهضها البوليس السّياسي في المهد.
لم أنقطع عن فاضل حتّى بعد أن غادرت منزله واختبأت في مكان آخر في «وادي قريانة» من ولاية منّوبة الآن. كنت أزوره أحيانا عندما كنت أزور صديقي الفلسطينيّ «معتصم» الذي يسكن في العمارة المجاورة. وكان يستقبلتي هو وزوجته بترحاب كبير رغم أن زياراتي لهما كانت دون سابق إعلام. ومازلت أذكر إلى اليوم كيف كان فاضل «يموت بالضّحك» على طريقة تنكّري. كنت أتحرّك في ذلك الوقت في هيئة رجل مُسنّ، ألبس «قشّابيّة»، وأضع «الطّربوشة» على رأسي، كان الفصل شتاء، ونظّارات «قاع دبّوزة» وأمشي «ملتويا»، متصنّعا إعاقة في ساقي اليمنى، مع «رعشة» كبيرة في اليدي اليمنى أيضا . كان البوليس السّياسيّ، يعرف هيئتي (silhouette) منذ اعتقالي في فيفري 1972 وكان عليّ أن أغيّرها. وما زلت أذكر كيف كنت أثير شفقة تلامذة المدرسة الابتدائية بالمنزه الأوّل القريبة من عمارة فاضل ومعتصم حين أمرّ أمامهم. كما أذكر كيف كان أصحاب سيّارات الأجرة (تاكسي) يقربون منّي أكثر ما يمكن حين أوقفهم وهم يقولون لي «ساعد روحك يا بابا... » بل كان فيهم من ينزل ويفتح لي الباب ويساعدني على الرّكوب. وكان انتباهي منصبّا دائما على لحظة النّزول حتّى أبقى على نفس الهيئة وأحافظ على نفس الحركات.
اعتقلت يوم 28 سبتمبر 1974 وأنا مارّ بحهة باردو (قرب مستشفى أبو القاسم الشابّي) بعد أن لمحني أحد جلّادي «أمن الدولة» وتمكّن من اعتقالي بمساعدة عوني أمن وعسكري كانوا مارّين بالمكان جلب انتباههما اصطدام سيارة مسؤول أمن الدولة بشجرة وهو يحاول دوسي. قضّيت ستّ سنوات كاملة بالسّجن.ولم ألتق فاضل من جديد إلّا بعد خروجي من السّجن في صائفة 1980. كرّس فاضل خلال تلك المدّة كاّفة جهده للإنتاج المسرحي والسّينمائي والفنّي. وكنت أتابع إنتاجاته كما كنت أتابع إنتاجات رفاق دربه الذين بدأوا معه المسيرة في فرقة مسرح الجنوب بقفصة وأذكر منهم خاصّة الثّنائي فاضل الجعايبي وجليلة بكّار اللّذين كتبا في مسرحهما تاريخ تونس وحملا قضايا شعبها وهمومه وهواجسه وأحلامه وأتعابه عبر فنّهما.
كانت عشريّة السّبعينات مفصلية في تاريخ تونس الحديث. كانت حبلى بالأحداث السّياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة. دخل نظام بورقيبة إثر تجربة «التّعاضد» في أزمة عميقة أحدثت انشقاقات داخله. وظهرت في السّاحة عدّة حركات سياسيّة، خاصّة يساريّة تقدّمية، تعرّض مناضلاتها ومناضلوها للاعتقالات والمحاكمات.كما ظهرت من كُمّ الحزب الحاكم حركة «الإخوان» في أفق مواجهة «المدّ اليساري». ومن جهة أخرى تعدّدت التّحركات والنّضالات الشعبيّة فكانت إشارة الانطلاق مع إضراب عمّال «الشّيمينو» سنة 1970. وبعده بثلاث سنوات جاء إضراب عمّال النّقل بالعاصمة. وفي سنة 1975 أضرب أساتذة التّعليم الثانوي وكان إضرابهم أوّل إضراب عامّ في الوظيفة العموميّة منذ عام 1956. ثمّ كانت تحرّكات عمّال الضّيعات الفلاحيّة سنة 1976 - 1977.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ إذ بدأت «عَدْوى» المطالبة بالدّيمقراطيّة وبالاستقلاليّة عن الحزب الحاكم تنتشر تدريجيّا. ومن أبرز الأحداث في ذلك الوقت صدور عريضة بجريدة «لوموند» الفرنسيّة أمضى عليها 600 نقابيّ يطالبون باستقلاليّة الاتحاد العام التونسي للشغل. صدرت هذه العريضة بعد مدّة قصيرة من انعقاد المؤتمر 14 للمنظّمة. وكان من بين معاني الاستقلالية في ذلك الوقت، استقالة الأمين العام للاتّحاد، الحبيب عاشور، من عضويّة الديوان السّياسي للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم.ثمّ جاء الإضراب العام بتاريخ 26 جانفي 1978 دفاعا عن كيان الاتّحاد واستقلاليّته وعن مطالب الشغّالين في وجه طغمة فاشيّة تروم إخضاعه بالقوّة. وقد أغرق نظام بورقيبة هذا الإضراب في الدّم وأوقف المئات من الكوادر النّقابية وعلى رأسهم الأمين العام للاتّحاد الحبيب عاشور وأحالهم كالعادة على محكمة أمن الدّولة فكان «قطع الحبل السرّي»، شكليّا على الأقل، بين الطّرفين إذ انتهى التنصيص في القانون الأساسي للمنظّمة على الارتباط العضوي بين الحزب الحاكم والمنظمة الشغيلة. وللتاريخ فقد كان لمناضلي/مناضلات اليسار الوافدين من الجامعة والملتحقين بقطاعات مهنية أساسية (تعليم ثانوي، بنوك، تعليم عال، سكك حديد…) دور حاسم في تغيير هويّة الاتّحاد وتجذير مطالبه.
ومن جهة أخرى شهدت السّبعينات ميلاد الحركة النّسائية الجديدة في النّادي الثقافي الطاهر الحدّاد. لقد نشأ جيل من النّسويّات أصبح يعتبر مجلّة الأحوال الشخصية تجاوزها الزّمن أمام الحاجة الملحّة إلى تحقيق المساواة التامّة في الحقوق بين الجنسين.كما عرفت البلاد في أواخر 1977 ميلاد الرابطة التونسية للدغاع عن حقوق الإنسان التي مهّدت لها لمدّة سنوات «لجان الدفاع عن ضحايا القمع» التي كانت تنشط في السرّية. وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت البلاد ما يمكن أن نسمّيه «انفجارا ثقافيّا». لقد تحدّثنا عن فرقة مسرح الجنوب بقفصة لكنّها لم تكن الوحيدة في الساحة. فقد برزت فرق أخرى في الكاف وباجة وغيرهما. كما بدأت تظهر أولى الأصوات الغنائيّة المتمرّدة وكان مسرحها الجامعة وأقصد هنا تحديدا الفنّان الأزهر الضّاوي أولى الشّموع التي بزغت في سماء الجامعة التّونسيّة لتشعّ لاحقا على كامل ربوع البلاد. ثم سيأتي ميلاد مجموعة «أولاد المناجم» الموسيقيّة (1977) على يد عمّال منجميّين كان همّهم التّعبير عن هموم الشّغيلة في تونس وخارجها. وفي سنة 1980 ستظهر مجموعة البحث الموسيقي بقابس. كما ستشهد نفس السّنة ميلاد مجموعة «الحمائم البيض» وقبلها بعام مجموعة أصحاب الكلمة 1979. وبعد ذلك بسنوات قليلة ستولد مجموعة «أغاني الحياة» بالدّهماني من ولاية الكاف. كلّ هذه المجموعات بعثتها ونشّطتها وجوه يساريَّةُ العقيدة. في ذلك الوقت بدأت تتسرّب إلى تونس أغاني الشّيخ الإمام ومارسيل خليفة الذي سيظهر في صائفة 1980 على ركح مسرح قرطاج.
ولا ننسى حركة نوادي السينما التي ازدهرت على يد ثلّة من مناضلي اليسار لتكون أداة، إلى جانب حركة السينمائيّين الهوّاة، لنشر الوعي التقدّمي ومواجهة الدّكتاتورية والاستبداد. وفي السبعينات أيضا سترتفع أصوات شعريّة مخترقة السّائد، ملتصقة بهموم النّاس من عمّال وفقراء ومهمّشين وكان من روّادها الطّاهر الهمّامي ومحمّد الحبيب الزنّاد وفضيلة الشابّي قبل أن ييرز منصف المزغنّي ومحمد الصغيّر أولاد أحمد وآدم فتحي ومن جاء بعدهم من أمثال بلقاسم اليعقوبي وعبد الجبار العشّ. وقد كان للرّواية دورها في خضمّ هذا المعترك الثّقافي. ومن بين الأسماء النّسائيّة التي لمعت عروسيّة النالوتي صاحبة «البعد الخامس» (1975) التي ستفتح الباب لعهد جديد من الأدب النّسائيّ.
كانت الثقافة حاضرة بقوّة في هذه المرحلة إلى جانب السّياسة والعمل النّقابيّ والحقوقيّ. وكانت من بين الأدوات القويّة في مقارعة الاستبداد ونشر الوعي الدّيمقراطي والتّقدميّ. وللتّاريخ فقد كان اليسار قلب رحى هذه الهبّة الثقافيّة. وفي كلمة كانت السبعينات إيذانا بمرحلة جديدة من تاريخ تونس يمكن القول إنه تشكل فيها المشروع السّياسيّ والاجتماعيّ والثّقافيّ للحركة الدّيمقراطيّة والتّقدميّة في تونس. لقد سقط صنم بورقيبة وبدأ التمرّد على الحكم الفردي المطلق يكتسح كافّة المجالات وبرزت رغبة النّاس الجامحة في العيش في نظام ديمقراطي وفي التمتّع بحرّيتهم. وللتاريخ فإنّ الفضل يرجع لحركة فيفري 1972 الطلّابيّة في دقّ المسمار الأوّل في نعش الحكم الفردي المطلق. لقد رفع الطلّاب المجتمعون في كلية الحقوق بالمركّب الجامعي أيام 1 و2 و3 و4 و5 فيفري لإنجاز المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس شعار: «لا مجاهد أكبر إلّا الشّعب». وكتبوه في العديد من اللافتات وازدانت به جدران الكليّة. لقد دخل «الشّعب» التّونسي بعمّاله وشبابه الطلابي ونسائه ومثقّفيه ومبدعيه حلبة التاريخ ليحاولوا صنعه بأنفسهم وعبر تجربتهم الخاصّة.
برز فاضل الجزيري إذن في خضمّ هذا الحراك الكبير. وكان المجال الثقافي وتحديدا المسرح والسينما والفنّ مجال فعله الأساسي واستمرّ على ذلك النّحو خلال الثّمانينات عبر أعمال لاقت رواجا كبيرا (مسرحيّة غسّالة النّوادر...). ولمّا حصل انقلاب 7 نوفمبر 1987 ودخلت البلاد مرحلة جديدة من القمع والاستبداد حكمت عليّ وعلى العديد من رفيقاتي ورفاقي بالعيش في السرّية، خارج أوقات السّجن بالطبع، انقطعت علاقتي بفاضل.لم يكن هو يراني بكلّ تأكيد لكنّني كنت أراه، حتّى وأنا بمخبئي في السرّيّة أو في السّجن، عبر أعماله الفنّيّة التي كان بعضها يبثّ عبر شاشة التّلفزة أو تعرض محتوياته في الصّحف (النّوبة 1991...). كنت والحقيقة تقال أتعرّف عليه أحيانا ولا أتعرّف عليه أحيانا أخرى... تغيّر الكثير في السّاحة السياسية والنقابيّة والثقافيّة والإعلاميّة حين أطلق بن علي زبانيته وراء كلّ صوت نشاز لإسكاته أو ترويضه فخيّر غالبيّة المبدعين عدا قلّة قليلة من «الرّؤوس الكاسحة» (les têtes dures) الذين اختاروا السّباحة ضدّ التيّار…
لم نلتق، فاضل وأنا، من جديد إلّا بعد سقوط الدّكتاتوريّة. كان من الواضح أنّنا نختلف إن فعلا أو من باب سوء التفاهم في أكثر من مسألة. ولكن ما ظلّ مستقرّا في ذهنينا، يجمعنا ويقرّبنا من بعضنا البعض، هو الرّغبة في خلق مناخ من الحرّية في بلادنا يسمح لكل مواطن/مواطنة بالعيش وبالتّعبير عن رأيه دون خوف. كما يسمح للفنّان بأن يبدع دون أن يكون في «رأسه» بوليس يراقبه ويوجّهه. إنّ الخوف وهو الشرّ المطلق الذي يَعشقَ المستبّدون زرعه في كلّ النّفوس لإطالة سلطانهم، يجرّد البشر من كرامتهم ويخلق منهم عبيدا لا مواطنين/مواطنات أحرارا. الخوف الذي «لا يمنع من الموت ولكنّه يمنع من الحياة»، ظلّ يرافق شعبنا منذ عهود سحيقة وحتّى عندما ظنّ أنّه هزمه ذات ثورة 2010 - 2011 أطلّ عليه برأسه من جديد في شكل شعبوي.
من بين ما عشته مع فاضل في أجواء ما بعد الثورة وقبل أن يجهضها أهل «الردّة» قبوله دون تحفّظ تنظيم ذكرى تأسيس حزب العمّال سنة 2015. كان التنظيم بشهادة الجميع على درجة كبيرة من الحرفيّة والذّوق والجمال...
وداعا فاضل.
ربّما لم أفيك حقّك بهذه الكلمات التي لم أتناول فيها إرثك الفنّي بالعرض والتّقييم والتّنويه. ولكن ثق بأنّ الأشياء التي تحدّثت عنها قد تبدو للقارئ اليوم بسيطة لكن ما كان لتلك الأشياء أن تبقى أكثر من نصف قرن ساكنة في نفسي إلّا لأنّها كانت من أجمل الأشياء التي عشتها في حياتي...
وداعا، وداعا أيّها الرّجل…
وداعا، وداعا أيّها المبدع
بقلم: حمة الهمامي