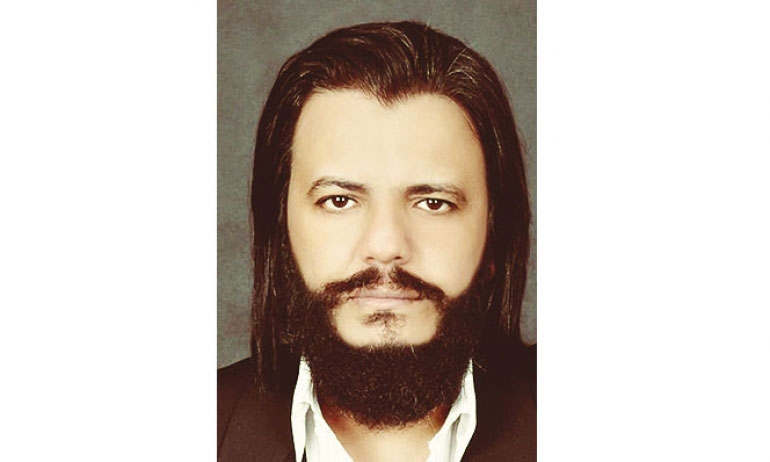حيث تُعتبر ليس فقط قضية وطنية فلسطينية، بل قضية الأمة العربية بأكملها ومفتاحاً لاستقرار المنطقة. في هذا السياق، جاء إعلان بغداد الصادر عن القمة العربية الأخيرة ليخصص ثلاثة عشر بنداً للقضية الفلسطينية، مؤكداً على مركزيتها السياسية والرمزية. لكن، وعلى الرغم من هذا التخصيص البارز، يظل السؤال المطروح: هل تعكس هذه البنود موقفاً عربياً فعّالاً وقادراً على مواجهة التحديات الراهنة، أم أنها تظل حبيسة الخطابات الدبلوماسية التقليدية؟
من الضروري التأكيد أن الوثيقة الختامية للقمم العربية، وليس التصريحات الجانبية أو الكلمات الافتتاحية مهما بلغت حدتها، هي التي تُشكل المرجع الأساسي لفهم الموقف الجماعي للدول العربية. وبالتالي، يُعد تحليل إعلان بغداد مدخلاً رئيسياً لتقييم التوجه العربي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. ما يلفت الانتباه في هذا الإعلان هو اعتماده على لغة دبلوماسية مخففة ومواقف عامة تفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه المواقف وقدرتها على إحداث تغيير ملموس. يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة نقدية لإعلان بغداد، مع التركيز على مضمونه، نقاط قوته، وما ينقصه من رؤية استراتيجية لدعم القضية الفلسطينية.
مركزية القضية الفلسطينية: خطاب روتيني بلا مضمون
يؤكد إعلان بغداد في بنده الثاني على "مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة العربية وعصب الاستقرار في المنطقة". هذا التأكيد، رغم أهميته الرمزية، لا يتعدى كونه جزءاً من خطاب روتيني تكرر في القمم العربية على مر العقود دون أن يترجم إلى سياسات عملية. فاللغة المستخدمة لوصف الإجراءات الإسرائيلية بـ"اللاشرعية" تبدو محايدة وغير متناسبة مع حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدمار الشامل في غزة، التشريد القسري، والحصار المستمر.
يتجنب الإعلان استخدام مصطلحات حاسمة مثل "الإبادة الجماعية" أو "جرائم الحرب"، مفضلاً لغة دبلوماسية قد تُفسر كمحاولة لتجنب الصدام مع القوى الدولية الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذا النهج يعكس حالة من التردد السياسي، حيث يبدو أن الجامعة العربية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين إظهار الدعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع الغرب. كان من الممكن أن يعتمد الإعلان على توصيفات قانونية دولية، مثل تلك الصادرة عن محكمة العدل الدولية أو تقارير الأمم المتحدة، لتعزيز موقفه وإضفاء طابع أكثر شرعية وحزماً على مطالبه. على سبيل المثال، كان بإمكان الجامعة أن تستند إلى تقرير الأمم المتحدة لعام 2023 حول الوضع في غزة، الذي وثّق انتهاكات إسرائيلية ممنهجة، لتدعيم موقفها بدلاً من الاكتفاء بلغة عامة.
الحرب في غزة: تهرب من تحديد المسؤولية
في البند الثالث، يطالب إعلان بغداد بـ"وقف فوري للحرب في غزة وجميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء". لكن هذا الطلب يتسم بالعمومية، إذ يتحدث عن "الحرب" كظاهرة مستقلة دون تسمية إسرائيل صراحة كطرف معتدٍ. هذا التجنب المتعمد لتحديد المسؤولية يُفقد الإعلان قوته السياسية ويُسهم في طمس الحقائق الميدانية، التي تُظهر عدواناً إسرائيلياً مستمراً يستهدف المدنيين والبنية التحتية في غزة.
علاوة على ذلك، يدعو الإعلان "المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات التأثير"، لتحمل مسؤولياتها، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذه الدعوة، رغم أنها قد تبدو منطقية في سياق دبلوماسي، تكشف عن محدودية الدور العربي في التأثير على الأحداث. فبدلاً من الاعتماد على قوى خارجية، كان يمكن للجامعة أن تقترح مبادرات عملية، مثل تنسيق حملة دبلوماسية موحدة في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إسرائيل، أو تشكيل لجنة عربية لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بغزة. كما كان بإمكان الدول العربية الاستفادة من أدواتها الاقتصادية، مثل تعليق الاتفاقيات التجارية مع الدول الداعمة لإسرائيل، لممارسة ضغط ملموس. غياب مثل هذه الاقتراحات يعكس افتقار الإعلان إلى رؤية استراتيجية واضحة.
حل الدولتين: التزام شكلي لا يصمد أمام الواقع
يجدد إعلان بغداد في بنده الثامن التأكيد على دعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. لكن هذا الالتزام يبدو شكلياً في ظل الواقع الميداني الذي تفرضه إسرائيل، حيث تُواصل تكثيف الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس، وتوسيع جدار الفصل العنصري. هذه السياسات تجعل حل الدولتين أقرب إلى فكرة نظرية منه إلى هدف قابل للتحقيق، خاصة في ظل غياب ضغط دولي حقيقي لوقف هذه الانتهاكات.
كان من الضروري أن يُشير الإعلان صراحة إلى أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وأن يطالب بإجراءات عقابية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو تجميد التعاون العسكري مع إسرائيل من قبل الدول الداعمة لها. علاوة على ذلك، يُغفل الإعلان في بنده الحادي عشر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1948، مكتفياً بالتأكيد على قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد أكتوبر 2023، مثل القرار 2720. هذا الإغفال يُضعف الحجة القانونية العربية، إذ كان يمكن للجامعة أن تستعرض تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية لتعزيز موقفها أمام المجتمع الدولي. على سبيل المثال، كان بإمكان الإعلان أن يُذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ليُبرز استمرارية التحدي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.
الوحدة الفلسطينية: دعوة مبطنة لتقييد المقاومة
في البند التاسع، يدعو إعلان بغداد الفصائل الفلسطينية إلى "التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة". هذه الدعوة تبدو إيجابية في ظاهرها، لكنها تحمل تلميحاً إلى ضرورة خضوع حركات المقاومة، مثل حماس، لسلطة الحكومة الفلسطينية المعترف بها دولياً. هذا الموقف يعكس تفضيلاً واضحاً لنهج التسوية السياسية على حساب خيار المقاومة ، دون الاعتراف بالإخفاقات المتكررة للمفاوضات في تحقيق الحقوق الفلسطينية.
كان من الأجدر أن يدعو الإعلان إلى حوار فلسطيني شامل يحترم تعددية الخيارات النضالية التي يكفلها القانون الدولي للشعوب تحت الاحتلال. على سبيل المثال، كان بإمكان الجامعة أن تقترح استضافة مؤتمر وطني فلسطيني تحت رعايتها، يجمع كافة الفصائل لصياغة رؤية مشتركة تحترم التنوع في الأساليب النضالية. كما كان يمكن أن تقدم دعماً مادياً وسياسياً ملموساً لتعزيز الوحدة الفلسطينية، مثل تخصيص صندوق عربي لدعم المشاريع الوطنية الفلسطينية، بدلاً من الاكتفاء بدعوات عامة.
فرص ضائعة: غياب المبادرات الاستراتيجية
يُثني إعلان بغداد على الدول الأوروبية (إسبانيا، النرويج، إيرلندا) التي اعترفت بفلسطين ، ويُشيد بموقف جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. لكن هذه الإشادات تظل في إطار الدعم اللفظي، دون ترجمة إلى مبادرات عملية. كان بإمكان الجامعة العربية استغلال هذا الزخم الدولي لإطلاق منصة "الجامعة العربية +3"، تجمع هذه الدول الأوروبية للضغط من أجل اعتراف أوسع بدولة فلسطين في أوروبا وخارجها. مثل هذه المبادرة كانت ستُعزز الدور العربي في المحافل الدولية وتُظهر التزاماً عملياً.
بالمثل، كان يمكن للجامعة أن تبني على موقف جنوب إفريقيا من خلال إنشاء منصة للتعاون القانوني، تشمل تبادل الخبرات في الإجراءات القضائية الدولية، أو حتى تقديم دعاوى مماثلة ضد إسرائيل. على سبيل المثال، كان بإمكان الدول العربية دعم تشكيل فريق قانوني عربي-إفريقي لمتابعة قضايا الانتهاكات الإسرائيلية في المحاكم الدولية. غياب مثل هذه المبادرات يكشف عن قصور في الرؤية الاستراتيجية، حيث تكتفي الجامعة بالإشادة دون استثمار الفرص المتاحة.
ملاحظات ختامية
يعكس إعلان بغداد حالة من التردد والضعف في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يسود الخطاب الدبلوماسي العام على حساب المبادرات العملية. لغته المحايدة وتجنبه تسمية إسرائيل كمعتدٍ، إلى جانب اعتماده على المجتمع الدولي بدلاً من مبادرات عربية مستقلة، يُبرز محدودية الدور العربي في مواجهة التحديات الوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. لتعزيز الموقف العربي، يمكن اقتراح التوصيات التالية:
1. تبني لغة حازمة: يجب على الجامعة استخدام مصطلحات قانونية دولية مثل "جرائم الحرب" و"الإبادة الجماعية" لتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية، مما يعزز الموقف العربي أمام المحافل الدولية.
2. آليات ضغط عملية: تحديد خطوات ملموسة، مثل المقاطعة الاقتصادية أو تعليق الاتفاقيات مع الدول الداعمة لإسرائيل، لممارسة ضغط حقيقي.
3. مبادرات استراتيجية دولية: إطلاق منصات تعاون مع دول داعمة لفلسطين، مثل جنوب إفريقيا والدول الأوروبية، لتعزيز الاعتراف الدولي بفلسطين ودعم الإجراءات القانونية.
4. دعم فلسطيني شامل: تقديم مساعدات اقتصادية وسياسية وقانونية للشعب الفلسطيني، بما يشمل تمويل مشاريع إعادة الإعمار في غزة ودعم مؤسسات السلطة الفلسطينية.
5. إعادة تقييم التطبيع: استخدام ورقة التطبيع مع إسرائيل كأداة ضغط لتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية، بدلاً من تقديم تنازلات دون مقابل.
6. تعزيز الوحدة الفلسطينية: دعم حوار وطني فلسطيني شامل يحترم تعددية الخيارات النضالية، مع تقديم دعم مادي للمشاريع الوطنية.
في النهاية، تتطلب القضية الفلسطينية مواقف عربية جريئة تتجاوز الخطابات الدبلوماسية إلى إجراءات ملموسة. يحتاج الشعب الفلسطيني إلى إرادة سياسية عربية قوية قادرة على استثمار الفرص الدولية، ومواجهة التحديات بفعالية، لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.